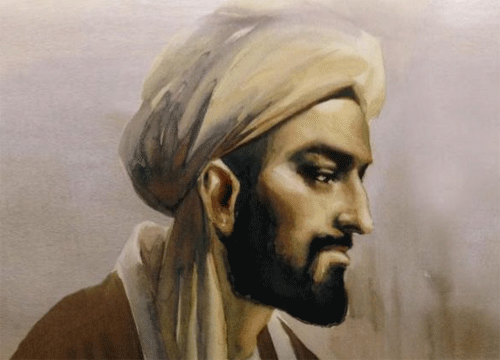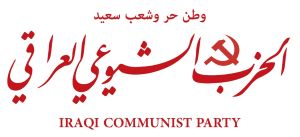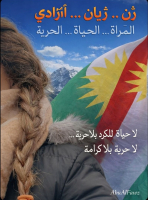يعـاود كتاب "ابن خلدون... فلسفته الاجتماعية" لغوستون بوتول الظهور إلى الواجهة من جديد، عبر ترجمة جديدة أنجزها غنيم عبدون، وراجعها مصطفى كامل فودة (دار أقلام عربية - القاهرة) بعد ترجمته الأولى التي صدرت عام 1955 بتوقيع عادل زعيتر، وبعد نحو ربع قرن من صدور النسخة الأصلية للكتاب عام 1930، التي تلتها طبعة ثانية عام 1934. وترجع أهمية هذا الكتاب لما يمثله مؤلفه من مكانة علمية في علم الاجتماع، فهو من أبرز من أعادوا الاعتبار لابن خلدون في الفكر الاجتماعي الغربي، وأسهم عبر اهتمامه المتكرر بمنجزه في إشاعة ذكره بين علماء الاجتماع وهواة الفلسفة والأدب.
يسلط الكتاب الضوء على عبقرية ابن خلدون متعددة الأوجه، فهو صاحب ثقافة موسوعية انعكست بوضوح في مؤلفاته. غير أن هذه الثقافة الواسعة لم تحجبه كما يشير بوتول عن التفاعل المباشر مع العالم الخارجي، على خلاف كثير من أقرانه من أهل البحث والدراسة الذين يميلون إلى العزلة والانكفاء على أوراقهم.
يرى بوتول أن سر عبقرية ابن خلدون يكمن في امتلاكه لخصيصة نادرة من خصائص العقول العبقرية، وهي قابليته الفطرية للانفعال والاندهاش والتساؤل إزاء مسائل يعتبرها الناس من البدهيات، فلا يتوقفون عندها كثيراً. فوجود الأسرات والسلطة والبدو والحضر، كلها أمور كانت مألوفة في نظر الغالبية، كما كانت التفاحة مألوفة قبل نيوتن. لكن ابن خلدون لم يرض بمجرد تقرير هذه الوقائع، بل راح يتأملها ويسأل لماذا؟ وكيف؟ ومن هنا انطلقت عبقريته.
نكبات متتالية
خاض ابن خلدون حياة مملوءة بالمحن والنكبات، إذ فقد أسرته وأساتذته في الطاعون الذي اجتاح شمال أفريقيا وهو لا يزال صغيراً، ثم فشل في بلوغ السلطة التي طمح إليها، مما أودى به إلى السجن. ولم تقف المآسي عند هذا الحد، بل فجع بغرق زوجته وأبنائه أثناء قدومهم للإقامة معه في مصر. نكبات متتابعة وسوء حظ لازم مسيرته في شمال أفريقيا، وفي الأندلس، وحتى في مصر التي لم يسلم فيها من الخلافات المتكررة مع علمائها، بسبب طبيعة شخصيته الصلبة والجافة. ويرى بوتول أن هذه المآسي كانت العامل الحاسم في تشكيل عبقرية ابن خلدون، «لولا هذه المآسي التي لحقت به لصار ابن خلدون شخصية كبيرة راضية عن ذاتها، ولكتب على أقصر تقدير مجموعة من الحكم العادية التي يوجد منها الكثير». فهذه النكبات جعلته يخوض تجارب نابضة بالحياة، «بل بلغت مرتبة الملحمة الشعرية أحياناً، مما جعل مؤلفات أرسطو ودروس موبيدان تبدو له تافهة لا تطابق الواقع» ص 140. وتكتمل مأساة ابن خلدون، الذي عاش في لحظة تاريخية فاصلة تزامنت مع انهيار الحضارة العربية، بأن مؤلفاته لم تلق ما تستحقه من اهتمام في زمنه، وبقي صوته من دون صدى. فلو أن كتاباته ظهرت في ظرف تاريخي أكثر خصوبة، لكانت كفيلة بتأسيس علم قائم بذاته، ولانطلقت منها مدرسة فكرية كاملة، ولأسست لسلسلة طويلة من الدراسات والأفكار، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. فـ"المقدمة" كانت آخر شعاع ينبعث مما سمي بحق "النهضة العربية"، قبل أن ينتقل المشعل إلى أوروبا، إذ ازدهرت العلوم وتحول ابن خلدون لاحقاً إلى مرجع يستعاد هناك، أكثر مما استحضر في بيئته الأولى.
عمل أصيل
يحدد بوتول في كتابه مواطن عبقرية ابن خلدون، فهو لم يكن مؤرخاً إخبارياً، وإنما كتب تاريخاً جامعاً ضخماً فريداً لا مثيل له منذ عهد فلاسفة اليونان، كما أنه قدم عملاً أصيلاً على وجهين، الأول من ناحية الموضوعية، فلم يكن في آداب الشرق شيء يشبه ما قام به ابن خلدون. والثاني أنه استخدم منهج الملاحظة على دراسة المجتمعات، هذا المنهج الذي استخدمه الفلاسفة العرب الكبار في مؤلفاتهم في العلوم الطبيعية والطب، لكن عبقرية ابن خلدون، كما يرى بوتول، تمثلت في نقله هذه المنهجية إلى مجال العلوم الإنسانية. وبذلك امتلك ابن خلدون القدرة على النقد السليم، والحرص العميق على الموضوعية، وهو ما يجعله سابقاً لعصره بقرون. ولعل السمة الرئيسة في مؤلفاته هي إيثاره للملاحظة والتجربة الواقعية على التفكير النظري المجرد، وبهذا يكون أدار ظهره تماماً لفلسفة القرون الوسطى في أوروبا، وبرز كرائد وإن لم يكن مؤسساً لفلسفة التاريخ، ولعلم الاجتماع القائم على الملاحظة وجمع الوقائع. يفسر بوتول أسباب أهمية "المقدمة"، موضحاً أنها ليست مجرد بحث نقدي في التاريخ، بل عمل تأسيسي غير مسبوق، ابتعد فيه ابن خلدون من اتجاه المؤرخين الشرقيين في جمع كل الروايات والوقائع من دون تمحيص، ووضعهم الأحداث التاريخية جنباً إلى جنب مع الأساطير التي تفتقر إلى التصديق، بدافع استعراض موسوعية معرفتهم، لا رغبة في التمييز بين الصحيح والزائف.
مبدأ الشك
في مواجهة هذا المنهج، أعمل ابن خلدون مبدأ الشك، وراح يمحص الروايات، ويقدم تفسيرات للظواهر الاجتماعية، محللاً أثر النشأة والبيئة في تكوين سمات الأفراد والمجتمعات. وكان ابن خلدون واعياً تماماً بفرادة ما يقدمه، وأشار صراحة إلى أصالة مشروعه، إذ قال في مقدمته: «واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث غريب النزعة، عزير الفائدة، أعثر عليه البحث، وأدى إليه الغوص». ولم يكن يدرك حينها أن ما يكتبه يمثل نشأة علم جديد، يتجاوز التعليم التقليدي للتاريخ، ويتجه نحو دراسة ما يسمى اليوم بـ"قوانين تطور المجتمعات الإنسانية". هذا المعنى الذي فطن إليه عالم الاجتماع النمسوي لودفيغ جومبلوفيتش، لاحقاً بقوله: "لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوغست كونت، بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوروبي، جاء مسلم تقي، فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن، وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة، وما كتبه نسميه اليوم: علم الاجتماع" ص 43.
ولا تتوقف جهود ابن خلدون التي سبقت زمنها في جعله فقط مؤسساً لعلم الاجتماع، بل تمتد إلى أن تكراره الدائم لأفكاره حول العلاقة بين المناخ والبيئة والنظام الغذائي من جهة، وأخلاق الشعوب وطبائعهم من جهة أخرى، يجعل منه شبه رائد لنظريات المادية التاريخية فهو يؤكد مراراً، وبالحرف الواحد: "اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم، إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش". هذه العبارة تتكرر في المقدمة بصيغ مختلفة، وهي تؤسس لفكرة محورية مفادها بأن الشروط المادية (المعاش) كالبيئة، ونمط الاقتصاد، وطبيعة النشاط اليومي هي ما ينتج البنى الذهنية والاجتماعية، لا العكس.
أفكار ثورية
طرحت مقدمة ابن خلدون خلدون مجموعة من الأسئلة المهمة التي أثيرت لاحقاً في أوروبا من بينها العلاقة بين الحضارة والبداوة، وتأثير المدنية في حريات الفرد. ففي القرن الـ18، طرح جان جاك روسو سؤالاً مشابهاً حول الأثر المفسد للحضارة والثقافة الفكرية والرفاهية المادية في الدول الكبرى، وتوصل إلى نتيجة قريبة مما ذهب إليه ابن خلدون بأن التقدم ينطوي على الاستبداد والفساد، ويفضي إلى تقليص حريات الأفراد. ليبقى السؤال قائماً: هل نختار البداوة بما فيها من استقلال وحرية، أم نخضع لحضارة المدن التي تقدم الرفاهية بثمن العبودية؟ فالكرامة والاستقلال الفردي يتنازعان مع متطلبات الحياة الحضرية التي تقوم على عبودية الأكثرية. ويقف بوتول معجباً بما وصل إليه ابن خلدون في هذه المسألة قائلاً: "وإنه ليؤثر في النفس أن نرى أحد رواد علم الاجتماع الأوائل وقد أوقفه هذا التناقض الذي تحاول مجتمعاتنا الحديثة أن تجد له حلاً" ص 143.
ويرصد بوتول مجموعة من الأفكار والنظريات التي تقاطعت مع أفكار ابن خلدون مع مفكري الغرب، مثلما هو الحال مع مكافيلي في كتابه «الأمير» الذي اشترك معه في معالجة دورة قيام الدول وانهيارها، وكان له اهتمام خاص بالنظام العسكري كركيزة أساسية لاستقرار الدولة.
معلومات مغلوطة
وسبق ابن خلدون نيتشه في فكرة رفض العبودية، فابن خلدون كان فخوراً بأنفته، وإذ كان عليه أن يختار بين العبودية والقبيلة المستقلة، فإنه سيرفض الحضارة لأن عبودية الأكثرية هي شرط قيام الحضارة، وسيفضل حياة البدو الذين لا يظهرون في الأمصار إلا لغزوها والسيطرة عليها. بقيت الإشارة إلى أن المترجم لم يتوان في الرد على عدد من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة التي أوردها بوتول عن ابن خلدون، مستعيناً بمصادر عدة، أبرزها دراسة ساطع الحصري عن "المقدمة"، التي خصص أحد فصولها لنقد كتاب بوتول تحديداً. ومن بين ما تصدى له المترجم، زعم بوتول أن ابن خلدون كان يؤمن بالخرافات، وأنه نسب بناء الآثار الرومانية إلى العمالقة. بينما الحقيقة هي أن ابن خلدون تناول هذه الأقوال بالنقد والتجريح في مواضع واضحة، لكن بوتول على ما يبدو لم يكلف نفسه عناء قراءة الفصل بأكمله فتوهم أن ابن خلدون يعتقد بصحتها ويقر بها. كما زعم أيضاً أن ابن خلدون تجاهل عمداً ذكر البلاد الأوروبية، بينما تظهر "المقدمة" خلاف ذلك، إذ إنها مذكورة في مواضع عدة، لا بنبرة استخفاف أو ازدراء، بل في كثير من الأحيان مقرونة بالإعجاب والثناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"اندبندنت عربية" – 22 ىب 2025