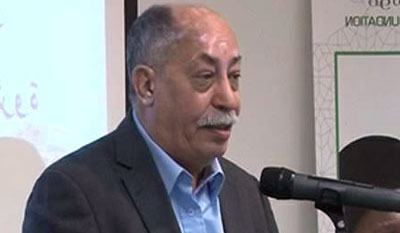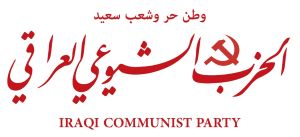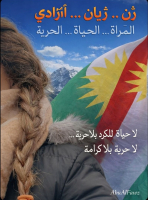في معاجم اللغة العربية مثل "لسان العرب" و"تاج العروس من جواهر القاموس" تعني مفردة الاصالة التميز والابتكار والجودة والعراقة في الفكر كنقيض للتقليد والمحاكاة.
تاريخيا جاءت الاصالة كنتاج للثورة العقلية الأولى للإنسان القديم قبل 70000 سنة كما عكستها نقوش ورسوم وأدب ما قبل التاريخ بما حوته من مضمون رمزي وجمالي وفلسفي وروحي رافقت ظهور الوعي والقدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر استجابة لحاجة الانسان القديم عن أجوبة لفضوله المعرفي عن ذاته والعالم المحيط به والتواصل على شكل قصص، ورقص وموسيقى ورسم ونحت.
ومع ارتقاء المجتمع البشري وظهور التشكيلات العبودية واكتشاف الكتابة الصورية المسمارية في بلاد الرافدين حوالي 3600 ق م التي تطورت لاحقا الى الكتابة المقطعية ثم الابجدية، كحاجة اجتماعية - اقتصادية لتوثيق المعاملات التجارية والمخزون الزراعي والتنظيم المجتمعي شكل ذلك انتقاله في الوعي البشري من الرمزية الى منظومة فكرية وفنية جمالية معقدة ومتشابكة حول السلطة، والاقتصاد، والدين، والهوية. وشملت الاصالة ظهور القوانين والرموز الدينية والعمارة ومنظومة جمالية مميزة من الادب والشعر الرومانسي المليء بالروحانيات عكست مفاهيم الحب، والصداقة، والخلود، والموت.
ورافق ظهور المجتمعات العبودية الكلاسيكية في أثينا وروما ارتقاء الفكر مجددا مع تاليس المالطي (624-546 ق م) مؤسس للمدرسة الايونية العقلانية الذي اعتبر الكون كلا موحدا ممهدا الى فكرة الجوهر الأول (يعنى الثابت والمستقل بذاته في الوجود الذي لا يقبل التجزئة وأساس كل ما يوجد) التي امتد صداها الى المدارس الفلسفية الغربية والإسلامية. وتواصل مع تباشير الفكر الفلسفي المادي في التحول الى تفسير الظواهر الطبيعية من الأسطورة الى العقل مثل أناكساغوراس (500 – 428 ق م) وديموقريطس (460 – 370 ق م).
وخلال قرنين من الزمان تكاملت المنظومة الفلسفية الاغريقية في نتاجات فلاسفة عظام منهم افلاطون (427-347 ق م) وارسطو (384-322 ق م) التي وصلت الى أوروبا لاحقا بفضل ترجمتها الى اللاتينية من قبل علماء الحضارة الإسلامية.
وجاء الصراع الثقافي في أوروبا خلال القرون الوسطى تعبيرا عن التحولات الاجتماعية التي رافقت نمو وتدهور التشكيلة الاقطاعية كالخلاف السياسي بين الكنيسة والسلطة الزمنية والصراع الفكري الحاد حول طبيعة العالم والكون والمعرفة والوجود وعن العلاقة بين الوحي والعقل. وقد ظهرت في تلك الفترة دعوات الى تحرير العقل من سطوة النص المقدس أو التوفيق بينهما مثل توما الاكويني (توفى في 1274).
وقد تعرض حملة الفكر المادي للاضطهاد والتكفير من قبل الكنيسة مثل ديفيد من دينانت (1160- 1210) والمدرسة الطبيعية في باريس بينما تميز في الجانب الاخر من العالم ابن رشد (1126-1198) بشروحه العميقة لأرسطو وتأكيده على أهمية التفاعل بين العقل والدين في سعيه لتأويل النص الديني بما ينسجم مع العقل كما اعتبر الدولة الفاضلة تبنى على المعرفة والعدالة وليس الدين. وفي الوقت الذي طمست أفكاره في الشرق الذي دخل قرون الظلام المعرفي ازدهرت أفكاره في أوروبا حيث نشأت المدرسة الرشدية اللاتينية ومنهم الإيطالي جوردانو برونو (1548- 1600) الذي أعدم حرقا بتهمة الهرطقة لدعوته لاستخدام العقل لمعرفة قوانين الطبيعة ورفض فكرة خلود الروح.
واعقبت القرون الوسطى في أوروبا مرحلتان تاريخيتان متداخلتان كجزء من تجليات البنية الفوقية المرتبطة ديناميكيا مع التحول التدريجي في قوى وعلاقات الإنتاج من الاقطاع الى الرأسمالية وهما عصر النهضة (القرن 14-17) اتسمت بالاهتمام بالفلسفة والعلوم والفنون وشهدت نهضة ثقافية وعصر التنوير (القرن 17-18) الذي شهد صعود العقلانية والتفكير العلمي والعلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والاحياء ومن روادها نيوتن (1643-1727). وشهدت تلك الفترة أيضا تطور الأفكار السياسية والفلسفية والاهتمام بالحرية الفردية وحقوق الانسان والتسامح الديني في بريطانيا مثل فرانسيس بيكون (1561 – 1626) وتوماس هوبز (1588 – 1679)، وجون لوك (1632 – 1704) وظهور الأفكار الليبرالية والمدارس الاقتصادية. بينما انتشرت في فرنسا مدرسة فلسفية مادية كان أحد روادها رينيه ديكارت (1596-1650) الذي اتبع مقاربة نقدية تعتبر العقل هو المقياس والبارون هولباخ (1723-1789) الذي رأى الكون تحركه قوانين طبيعية.
ومن الفلاسفة اللذين تركوا تراثا فكريا بالغ الأهمية هو الهولندي سبينوزا (1623-1677) لما قدمه من منظومة فلسفية شاملة اعتبرت الطبيعة والخالق والعقل والجسم صفتان لنظام وجوهرا واحدا. ومن اهم الرموز الفلسفية الألمانية الحديثة كان إيمانويل كانت (1724-1804) الذي كان مهتما بحدود وقدرات العقل البشري في معرفة العالم و طور نظريات في الاخلاق والجمال والفن ونرك بصماته على التطور اللاحق للفكر الألماني مثل شوبنهاور ( 1788-1860) وفيخته ( 1762-1814) و هيجل ( 1770-1831 ) الذي اتبع المنهج الديالكتيكي في تحليل الظواهر الطبيعية و التاريخية ولكن بمنظور مثالي.
وقد لعبت الطبقة البرجوازية في بداية صعودها دورا تقدميا في فترة احتدم فيها الصراع الثقافي والاجتماعي خاصة في ميادين العلوم الطبيعية والفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية بين الاتجاهين الرئيسين المادية التي ترى العالم كواقع مادي والمثالية التي اعتمدت المقاربات الميتافيزيقية التي تؤكد على أولوية الروح وهيمنة النص المقدس على العقل والفكر.
وكان هذا المسار الفكري صعبا ومعقدا حتى انعطافه التحول الثقافي في أوروبا نتيجة تقدم العلوم الطبيعية كالفيزياء والطب والحياة والأرض والكون وخروج العلوم الإنسانية من معطف الفلسفة المثالية فظهرت تخصصات كعلوم النفس والاجتماع والتاريخ والأنثروبولوجيا وغيرها.
وانتشرت أيضا مفاهيم الحرية والإنسانية والأفكار الاشتراكية الطوباوية كتجسيد لشعارات الثورة الفرنسية (1789) تهدف الى إقامة مجتمع العدالة والمساواة ومن رموزها روبرت اوين (1771-1851) وشارل فورييه (1772-1827) ولويس بلان (1811-1882) وسان سيمون (1760-1825).
ويمكن تتبع سير الفلسفة المادية الحديثة من ارهاصات عصر التنوير الفكرية الى فلسفة الألماني فيورباخ (1804-1872) وهو أحد اليساريين الهيجليين اللذين تصدوا لميتافزيقية هيجل الذي اعتبر الروح هي المحرك الأساس غايتها تحقيق الروح المطلقة. وقدم فيورباخ تفسيرا ماديا كانت الأولوية فيه للمادة على الروح وأن الإدراك الحسي للفرد هو الذي يحدد فهم العالم وقدم نقدا فلسفيا هاما للدين لكنه أهمل دور النشاط الاجتماعي – الاقتصادي في تشكل الأفكار. ثقافيا استخدم مفهوم الحداثة في اوروبا للدلالة على هذه التحولات في مجالات التكنولوجيا والعلوم والفلسفة والفن والأدب.
وقد رافق صعود التشكيلة الرأسمالية في القرن الثامن عشر ظهور الطبقة العاملة التي يبيع أفرادها قوة عملهم لقاء أجر في صراع مستمر مع الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج لتحسين ظروف العمل وانهاء الاستغلال الطبقي والذي اتخذ شكل انتفاضات عمالية أولها كانت لعمال النسيج في إنجلترا عام 1811 ثم امتدت الى فرنسا وبلدان أوروبية أخرى في القرنين التاسع عشر والعشرين والتي شكلت القاعدة الاجتماعية لظهور المنظومة الفكرية الماركسية من فلسفة واقتصاد سياسي واشتراكية علمية ( لتمييزها عن الاشتراكية الطوباوية ). ومع سعة التفاصيل عن المنظومة الفكرية التي طرحها كارل ماركس (1818-1883) وفردريك انجلز (1820 -1895 ) الفلسفية الاقتصادية والسياسية، الا أن القضية الرئيسية التي شكلت إضافة نوعية في مسار الفكر الإنساني هو تأكيدهما على أن الكون والطبيعة والأفكار والمجتمع تسير في حالة حركة وتطور دائمة وفق قوانين عامة يمكن معرفتها والتحقق منها عبر المقاربة المادية الجدلية (المادية الديالكتيكية و المادية التاريخية) . وطبقا لهذه المنظومة الفكرية تتطور المجتمعات وتتعاقب وترتقى التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية وبحتمية وصولا الى الاشتراكية والشيوعية بفعل الصراع الطبقي والتناقضات المحتدمة وبفعل الثورات الاجتماعية كمحرك أساس لتقدمها . والأكثر من ذلك، أن هذه المنظومة الفكرية تتعدى حالة تفسير العالم الى تغييره عبر الممارسة الثورية (البراكسيس) من خلال ثورة سياسية واقتصادية واجتماعية هدفها تحقيق البناء الاشتراكي على أنقاض الرأسمالية.
في هذه الأجواء الفكرية نشأت ما بعد الحداثة كحركة ثقافية فكرية فلسفية تشكك بالأسس العقلانية والعلمية لمفهوم الحداثة وتلغى دور السرديات الكبرى الدينية والهيجلية والكانتيه والماركسية عن الحقيقة المطلقة ولانهائية المعرفة والتركيز على تحليل وتفسير الجزئيات المرتبطة بالسلطة وعلاقات القوة وديناميكيات الهيمنة عبر تفكيك النصوص والأفكار واللغة، كما امتدت الى مجالات الأدب والجمال والفن والعمارة وتدعو الى التعددية الثقافية وأنماط من الهويات. وفي مجموعها عكست ما بعد الحداثة ردة فعل في أوساط النحب الثقافية تجاه مآسي الحرب العالمية الثانية ومجازر الفاشية بحق الشعوب الأوروبية، ولكن في سياق هيمنة ثقافة الرأسمالية المعولمة لصياغة فكر ينسجم مع متطلبات الحرب الباردة في الوسط الثقافي الأوروبي.
ومن أهم مفكري ما بعد الحداثة ميشيل فوكو (1926-1984) الذي ركز على نقد السلطة والمعرفة وتحليل الخطاب والهوية ومؤسسات مثل السجون والمصحات العقلية. وأسس جاك دريدا (1930-2004) الذي طور النظرية التفكيكية لتحليل النصوص الأدبية والفلسفية للكشف عن معانيها الخفية وتناقضاتها بينما قدم جان بودريار (1929-2007) الذي انتقد المجتمعات الاستهلاكية والثقافة الشعبية ودور الرموز والعلامات في صناعة فهمنا للعالم بواسطة الاعلام. ومن مفكريها أيضا رومان بارت (1915-1980) من الذين انتقد الثقافة الشعبية الاستهلاكية وأهمية الإشارات والعلامات في اللغة والثقافة.
كما نمت في فرنسا فلسفة البنيوية الحداثية ومن ممثليها عالم الانثروبولوجيا ليفي شتراوس (1908-2009) والمحلل النفسي جاك لاكان (1901-1981) والماركسي لويس التوسير (1918-1990) ولكن في بدايات القرن الحالي طرح مفهوم " ما بعد بعد الحداثة " دلالة على موتها .
ولكن عادت الماركسية مجددا الى الواجهة بعد وفاة ماركس بما حملته من مضامين ثورية وبعد سلسلة من الانتفاضات العمالية في أوروبا توجها انتصار ثورة أكتوبر في روسيا التي قادها لينين (1870-1924) في 1917 وتشكل المنظومة الاشتراكية القائمة بعد الحرب العالمية الثانية وتصاعد حركات التحرر الوطني.
وقد برز بعد ماركس الكثير من المفكرين الماركسيين مثيرين للجدل في أوروبا منهم روزا لوكسمبورغ ( 1871-1919 ) وجورج لوكاتش ( 1885-1971 ) وغرامشي (1891-1937 ) وعرب منهم مهدي عامل ( 1936-1987) وحسين مروة ( 1910-1987 ) وسمير امين (1931-2018 ) وفالح عبد الجبار (1946-2018)، اضافوا الى الخزين التاريخي للماركسية التي أصبحت هدفا خلال سنوات الحرب الباردة بهدف شيطنة الماركسية وتشويه مضامينها الثورية والترويج لصيغ بديلة تهادن الأيديولوجيا النيوليبرالية حتى انهيار الاتحاد السوفيتي والعالم الاشتراكي نتيجة الاخطاء المتراكمة على صعيد النظرية والتطبيق. ومن الجدير بالذكر ان ما هو مشترك في معظم بدائل الماركسية التي تم نشرها في مراكز أكاديمية غربية هو انتقاء جزئيات من المنظومة الفكرية الماركسية وتجريدها من قوانين تطور التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية وحتمية الاشتراكية ومن الممارسة الثورية ومزاوجتها بأخرى من علوم الاجتماع، والانثروبولوجيا ونتاجات ما بعد الحداثة.
ولكن جاء مع هذا الانفجار نقيضه في تشكل فضاء فكري رحب وواسع لاعتماد المقاربة الجدلية النقدية الماركسية بشقيها النظري والتطبيقي التي لا تتوقف عند أطر أو مسلمات جامدة والتي تنطلق من حقيقة أن التاريخ في حركة دائمة تتطور وفق قوانين مادية وذات بنية سياسية وروحية وأخلاقية تعكس التناقض بين قوى وعلاقات الإنتاج في نظام اقتصادي ريعي مستهلك وغير منتج كما هو في الحالة العراقية.