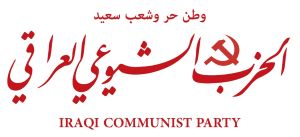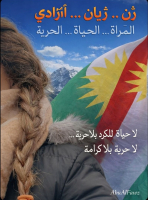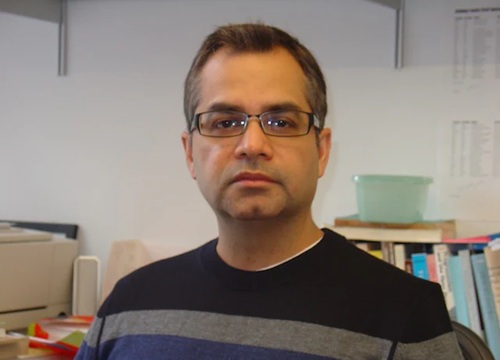
إن عجز اليسار اليوم عن التأثير ليس صدفة، بل هو نتيجة لبنيته التنظيمية. وإذا كان يريد أن يبني قوة جديدة، فعليه أن يغيرهذه البنية من الأساس.
اليسار الحديث نشأ كتعبير سياسي عن المصالح المادية للطبقة العاملة. ففي بداياته كان مجرد تجمع فضفاض يضم مثقفين ونقابيين وأعضاء متعاطفين من النخب السياسية، واقتصرت أنشطتهم في الغالب على الصحافة، والمناظرات الأخلاقية، والعمل الاجتماعي، وفي بعض الحالات على الرعاية السياسية. غير أنّ الطبقة العاملة وحلفاءها من الأوساط الأكثر نخبوية أدركوا في أواخر القرن التاسع عشر أنّ عليهم أن ينظموا أنفسهم كطبقة من أجل فرض مصالحهم السياسية والاقتصادية.
من المهم التأكيد على أنّ هذا الإدراك لم يأتِ إلّا من خلال تجارب قاسية. ولم يكن الأمر نتيجة تحوّل ثقافي أو تبدّل في أذواق فكرية جعلت التنظيم الطبقي يتقدّم على أنشطة أخرى. في الواقع، لم يجري التخلي عن أيٍّ من تلك الأنشطة: إذ واصل الاشتراكيون الاعتماد على الحجج الأخلاقية ضد الرأسمالية، وانتقدوا في الصحافة مظالم الطبقة العاملة، كما استخدموا ما لديهم من نفوذ سياسي لتحسين الأوضاع.
لكنهم اكتشفوا أنّ مطالبهم، من دون قوة فعلية، كانت تُتجاهل في أحسن الأحوال، أو تُقمع بالقوة من قبل أصحاب العمل وممثليهم السياسيين في الدولة. ومن خلال هذه التجربة التعليمية تحوّلَت «المسألة الاجتماعية» في أوائل القرن التاسع عشر إلى «المسألة الطبقية» مع نهايته.
ركيزتا الحركة العمالية
تشكّلت مؤسستان أصبحتا الركيزتين الأساسيتين للحركة العمالية المنظمة: النقابات والأحزاب الاشتراكية. ففي بعض البلدان ظهرت الأحزاب أولاً، فمهّدت الطريق لتنامي قوة النقابات. وفي حالات أخرى اجتمعت النقابات نفسها لتؤسّس أحزاباً تُشكّل ذراعها السياسي. وبغض النظر عن ترتيب النشأة، صارت هاتان المؤسستان في معظم أنحاء العالم.
باستثناء الولايات المتحدة، حيث استُبعدت الأحزاب الاشتراكية فعلياً من المشاركة السياسية - الأساس الذي قامت عليه إنجازات الحركة الاشتراكية في القرن العشرين.
وبعد أكثر من قرن ما تزال النقابات في صميم الاستراتيجيات الاشتراكية. والسبب في ذلك بسيط: مكان العمل هو الموقع الذي يلتقي فيه العمال بأعداد كبيرة في كل مجتمع رأسمالي. لكن هذه ليست الميزة الوحيدة التي تجعل مواقع العمل بهذه الأهمية، إذ يمكن لأبناء الطبقة العاملة أن يجتمعوا أيضاً في أحيائهم، على سبيل المثال.
غير أنّ الأهمية المركزية لمكان العمل تنبع من كونه الموضع الذي تُنتج فيه «القيمة». ووقف تدفق عملية إنتاج القيمة هو جوهر القوة التي تملكها الطبقة العاملة. فالنقابات تجمع العمال وتستخدم سيطرتهم على القيمة الاقتصادية كوسيلة ضغط على أصحاب العمل. ومن ثم، عندما يسعى الاشتراكيون إلى تنظيم العمال على أساس مصالحهم، فإن نجاح ذلك ببساطة لا يمكن تصوره من دون أن تكون النقابات في مركز هذا التنظيم.
ومع أنّ النقابات لا غنى عنها لتنظيم العاملات والعمال، فإنها لا تستطيع تنظيمهم كطبقة إلاّ جزئياً. فكما لاحظ فلاديمير لينين، تُمكّن النقابات الطبقة العاملة من النضال من أجل مصالحها، لكن في حدود ضيقة. فهي تساعد على تحقيق تحسينات في الأجور، وظروف العمل، وساعات العمل وإيقاعه. وتشكّل وسيلة للعمال من أجل الدفاع عن مصالحهم في مواقع العمل والحفاظ على قدر من الكرامة الإنسانية داخل النظام الرأسمالي.
لكن حدودها تكمن في أنها تركّز الاهتمام على تفاصيل العقد الفردي لكل عمل، بدل التشكيك في المبدأ الكامن وراء العقد نفسه. وهنا يواجه الاشتراكيون مفارقة واضحة: فالنقابات لا غنى عنها لحماية مصالح العمال داخل الرأسمالية، لكنها في الوقت ذاته تضفي الشرعية على النظام الذي يسعى الاشتراكيون إلى تجاوزه. وهذه ليست مسألة أيديولوجية فحسب، بل عملية أيضاً: إذ إنّ مسؤولي النقابات تقع على عاتقهم مهمة الدفاع عن مصالح العاملين في أماكن عملهم، ولذلك يميلون إلى التركيز بشكل أحادي على مشاكل ذلك المكان المحدّد، بدل الانشغال بالنظام ككل.
وفوق ذلك، وبحكم أنّ النقابات نشأت لضمان رفاه أعضائها المباشرين، فإن لديها نزعة داخلية إلى تفتيت الطبقة العاملة. ويتضح هذا بشكل جلي في حالة النقابات الحرفية أو نقابات الأصناف التي سادت في القرن التاسع عشر، حيث كان العمال يُنظَّمون بحسب مهاراتهم أو مهنهم. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل يشمل أيضاً الشكل النقابي الصناعي الذي ساد منذ ثلاثينيات القرن العشرين: صحيح أنه ينظم عمال مؤسسة أو قطاع بعينه، لكنه لا يحمل في طبيعته توجهاً نحو جمع العمال جميعاً في وحدة طبقية شاملة.
هذه القيود هي السبب في أنّ الجناح الاشتراكي من الحركة العمالية اعتبر على الدوام أنّ وجود حزب سياسي أمر لا غنى عنه. فالأحزاب العمالية أو الاشتراكية تميّزت تاريخياً بميزتين اثنتين تفتقر إليهما النقابات بحكم طبيعتها: الأولى أنها لا تنظَّم فقط على أسس اقتصادية، بل أيضاً على أسس أيديولوجية. فهي تسعى إلى تغيير البنية الأساسية للرأسمالية لصالح الطبقة العاملة ـ أو، في صيغة أكثر طموحاً، إلى تجاوز الرأسمالية كلياً.
يمكن تلخيص هذه العلاقة على النحو التالي: بينما تناضل النقابات من أجل المصالح اليومية لأعضائها، تضع الأحزاب استراتيجية طويلة المدى تخص الطبقة ككل. فالأحزاب تميل إلى النظر إلى الاقتصاد في مجمله، في حين تبقى النقابات مركّزة باستمرار على خصوصيات قطاعها أو مهاراتها المُتخصّصة.
ومن الخصائص المهمة الأخرى أنّ الأحزاب تمتلك منفذاً إلى الدولة. ففي القرن التاسع عشر لم يكن لهذا الأمر أهمية كبرى، إذ إنّ معظم العمال كانوا مستبعدين أصلاً من المشاركة في النظام الانتخابي. غير أنّ ديمقراطية الدولة الرأسمالية جعلت من إمكانية تغيير ميدان الصراع الطبقي عبر الوسائل التشريعية ركيزةً مركزية في استراتيجية الطبقة العاملة. وهكذا صارت الأحزاب الناشئة الأداة الأقوى لدفع مصالح الطبقة العاملة إلى الأمام.
لقد عملت هذه الأحزاب مع النقابات، لكنها احتفظت ببنية تنظيمية خاصة بها. وبكثير من الجوانب كانت الأحزاب، شأنها شأن النقابات، منظمات كفاحية: فقد كانت متجذرة مادياً في الأحياء العمالية، تستقطب أغلب أعضائها منها، ومرتبطة بعمق بحياة الطبقة العاملة، إلى درجة أنّ الحزب والجماهير شكّلوا وحدة عضوية واحدة.
غير أنّ دور الأحزاب لم يقتصر على استخدام العمال كقاعدة جماهيرية، بل سعت بنشاط إلى تشكيل الثقافة الأيديولوجية والسياسية للطبقة بأسرها. كانت لها رسالة سياسية متماسكة، وثقافة غنية من النقاشات والجدالات الداخلية، مع معايير واضحة في صفوفها، وفرص للصعود إلى مواقع القيادة. وقد كانت جميع الأحزاب الاشتراكية في القرن العشرين تفخر بانضباطها الداخلي وبالعزم الذي انخرطت به في العمل السياسي. بدا أن الاشتراكية وكأنها تلوح فعلياً في الأفق؛ لم يكن الأمر ليطول بعد. فما الذي حدث إذن؟
-----------------------
(*) فيفيك تشيبر: أستاذ علم الاجتماع في جامعة نيويورك، ورئيس تحرير مجلة «Catalyst: A
Journal of Theory and Strategy»، ومؤلف من بين أعمال أخرى كتاب «أبجدية الرأسمالية».