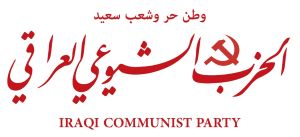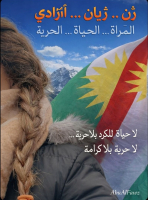إن الذات الشعرية الواعية تلعب دوراً مهماً في استنطاق المعطيات الحياتية عبر عمليات ذهنية وحسية وتخييلية ، وتلك العمليات لها أدوارها المهمة في بناء الشعر، وبذلك تصبح التجربة بشقيها (الحياتي والشعري) المصدر المعتمد لمعارف الشاعر ورؤاه، التي يسعى الشاعر إلى استنطاقها والكشف عن ماهيتها لتتحول فيما بعد إلى معانٍ ورموز يتعامل معها المتلقي كمفاهيم تفصح عن الرؤيا المعرفية عند الشاعر، وهذا ما يمكن معاينته في مجموعة الشاعر (ولاء الصواف) والموسومة (طائرٌ نَسيَ أن يغلقَ بابَ العش).
اختار الشاعر عنوانين لمجموعته الشعرية الأول (كلبٌ ينبحُ فوق الغيم)، ولقد اخترنا العنوان الثاني (طائرٌ نَسيَ أن يغلقَ بابَ العش) يفصح عن تشكيل معرفي ينجز مهمته الشعرية بانفتاح دلالي يشّكل بؤرة التصورات المعرفية التي تعكس سياق الشاعر الذي يروم بلوغ درجة يرصد شقاءها الإنساني:
الأسوَد سيدُ الألوان
الأحمرُ سيدُ الموقف
يا بلادي العتيقة كالفرح ... كلّكِ فرحٌ يقضمني
في المقطع الآنف استثمر فيه الشاعر لونين لهما دلالاتهما الواقعية (الأسود والأحمر)، وهاتان الدلالتان جاءتا بوصفهما موجهاً يسعى الشاعر من ورائه لبيان أن جوهر الحياة هي بالضد من الموت والحزن، إذن هناك تلاحم دلالي بين (الأسود/ المراثي) وبين (الأحمر/ الموت) ، فسياق التحول في هذا التلاحم الدلالي ابتدأ من التجربة الحياتية إلى التجربة الشعرية مما تبعها تحول في الرؤيا التي وضعتنا أمام السؤال المعرفي، الذي كشف عن محنة إنسانية ووجودية.
ووظائف التأمل الشعري هو تحويل الأشياء المدركة والمتعينة إلى عوالم مفارقة بعد استنطاق طاقتها الإيحائية، إن الشاعر لكي يضمن تجربته كثيراً ما يحوّر المعطيات لغرض فتح الطريق للتفاعل معها، فهو لا يستأثر بها كما هي، مما يترتب على هذا التفاعل حوارية دائمة بين (الذات والموضوع) يعيد عن طريقها إنتاج الوقائع وفقاً لرؤيته، وهذا ما فعله الشاعر مؤكداً التوصيف:
دعني أمارسُ جنوني في هذا العالم
كما أشتهي .... لا كما تشتهي الريح
ثم يختتم نصه بالآتي:
كلُّ ما أنا ....
نفثةُ دخانٍ أنيقٍ
أهيل الهواء عليَّ لأتبدد
يتشظى النص الآنف من نقطة تمركز واحدة وهي (الأنا) التي وصفها بالجنون، وهذه (الأنا) افترضت دلالات متجاورة تتماهى وحقيقتها المضطربة، ومن هذه الدلالات (الريح) و (الدخان)، وهكذا يصل بنا الشاعر إلى الثنائية الوجودية الكبرى التي افتتح بها مجموعته الشعرية وهي ثنائية (الموت والحياة)، وإن الموازنة بينهما هي بحسب التشاكل الذي يتمحور حول المقصد العام للنص وهو (الأنا) بمسارها المعرفي الذي يتحتم عليها الجنون بحسب رغبتها، لا كما تشتهي الريح بحد وصف الشاعر، وبذلك يكشف مسار التجربة عند (ولاء الصواف) نزوعاً إلى تصور الحياة وكأنها جحيم، وهذا النزوع يؤكد أن هناك تجلياً مأساوياً يؤسس إلى نظرة جديدة إلى العالم، تدفع الإنسان لاكتشاف شتى القضايا التي تحفّ به، مما يحّول الاحتمالات عند الشاعرــ إزاء هذا الوضع ــ إلى ممكنات لا تتوقف عن صناعة الواقع، وهذا ما يمكن تأكيده:
للمهملِ أبداً ... رأسي الضاج بالأسئلة
من أغلقَ بابَ السؤالِ عمّن أكون؟
من عبأ في جسدي النحيل كلَّ هذا الزبد؟
من خلعَ شرفاتِ التأويلِ عن فكرةٍ مجنونةٍ أسمها (أنا)؟
أنا هنا في مفترقِ الوجود
لقد وضعنا الشاعر أمام تساؤل معرفي أنطلق من (الأنا) ليحدد مصيره هو، وبالضرورة ذاته مصير الإنسانية التي تواجه سؤال الوجود (عمّن أكون)، إضافة إلى ذلك إن وعي التجربة قد ركن إلى اللحظة الحاضرة التي عن طريقها حدد المصير الإنساني، ووفقاً لهذا التحديد كرر الشاعر لازمته الشعرية وهو السؤال بــ(من)، الذي صار بؤرة النص وتمركزه الدلالي، وهذه اللازمة تفصح عن توجه الشاعر المعرفي، بمعطياته المعرفية والوجودية ، واندفع منها إلى أقصى درجات التجريد.