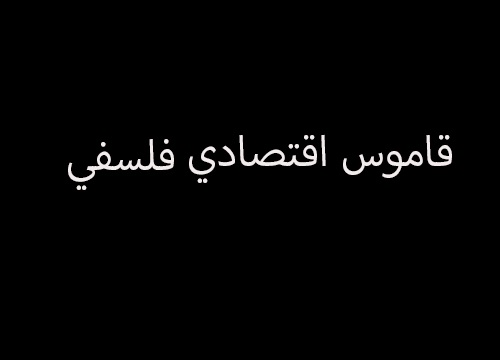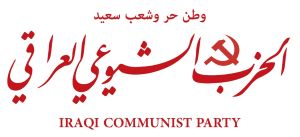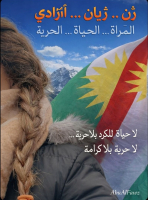في المجتمعات الطبقية تستخدم العديد من المعايير للتمويه على التفاوتات الاجتماعية الفعلية. ومن بين هذه المعايير نتوقف عند معيار متوسط دخل الفرد الواحد من الدخل القومي. بداية، لا بد من القول أن مؤشر متوسط دخل الفرد الواحد (وللاختصار سنشير له لاحقا – المؤشر) تعرض في الأدبيات الاقتصادية الى انتقادات كثيرة وهي معروفة ولا توجد حاجة الى تكرارها هنا. ولكن ما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة تجاوز لعبة الأرقام والمقاربات الفنية فللأرقام الإحصائية وظيفة أخرى، وهي وظيفة إيديولوجية بامتياز، أي التعتيم على الواقع أو تجميله. إن لعبة الأرقام والمقارنات الإحصائية مغرية للغاية وقد تريح عقول صناع القرار السياسي والاقتصادي لكنها رغم ذلك لا تستطيع أن تغير من صرامة الواقع شيئا. فمثلا لو اعتمدنا هذا المؤشر على العراق فإنه لن يساعد على الكشف عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المزري الذي تعيشه قطاعات واسعة من المجتمع العراقي والتي تعاني من التهميش والإقصاء.
مشكلة هذا المؤشر – ومن هنا تتأتى وظيفته الإيديولوجية - انه يتناول المجتمع وكأنه كتلة صوانية متماثلة وان أفراده مجرد قامات متساوية في الطول والعرض.. يتمتعون بنفس المواقع في البنية الاجتماعية/الطبقية. وإذا اخذنا المثال العراقي مثلا فإنه في عام واحد ازداد دخل الفرد الواحد بـ 500 دولار (من 4000 دولار الى 4500)، وبموجب هذا الرقم الذي يحمله (المؤشر) يبدو الأمر، للمواطن البسيط العادي، كما لو أن كل فرد عراقي حصل في عام 2012 على 4500 دولار (بعد ان كان قد بلغ 4000 دولار في عام 2011) وأن دخله زاد خلال العام ذاته بمقدار 500 دولار، فهل هذا صحيح في الواقع الفعلي؟. قد تكون حصلت زيادة في الحجم الإجمالي للدخل القومي ولكن (المؤشر) العتيد لا يقول لنا: ما هي القوى الاجتماعية التي استحوذت على الجزء الأكبر من الدخل، وكم حصلت الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والأكثر فقرا منه؟ وهل حقا حصلت على جزء ولو ضئيل من هذه الزيادة مما ساهم في تغيير مواقعها في البنية الاجتماعية والطبقية؟ في واقع الأمر، هذا (المؤشر) غير معني بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بكيفية توزيع هذه الثروة، فهو إذن لا يطرح إشكالية علاقات الإنتاج والتوزيع وإعادة التوزيع، ومن هنا الوظيفة الآيديولوجية (الآيديولوجيا هنا بمعناها السلبي) لهذا المؤشر.
والعيب الآخر الذي يعاني منه هذا (المؤشر) انه لا يدلنا على الكيفية التي يتم فيها توزيع الدخل القومي بين القطاعات الاقتصادية من خلال إبراز حصة كل قطاع منها في إنتاجه. ونظرا لان البنية القطاعية للاقتصاد العراقي تمتاز بهيمنة القطاع النفطي فيها من جهة، وبضعف قطاعات الإنتاج المادي، كالزراعة والصناعة التحويلية من جهة أخرى، فان القبول بهذا المعيار ونتائجه يعني التعتيم على الطابع الريعي والمتخلف والأحادي الجانب للاقتصاد العراقي.
والأمر الأخطر من ذلك هو انه ورغم أن بلادنا تتمتع بـ "ميزة" أنها تقع في مقدمة قوائم البلدان التي تعاني من الفساد، بحسب دراسات ومعطيات مؤسسات دولية يرتكن إليها، فان مؤشر حصة الفرد الواحد لا يقول لنا شيئا ولو بسيطا عن مستوى هذا الفساد ولا القوى المستفيدة منه ولا حجم المبالغ المستحوذ عليها من طرف هذه القوى نتيجة موقعها في بنية السلطة وصناعة القرار أو استنادها الى دعم من مراكز صناعة القرار، على مختلف العد.
إن اعتماد هذا (المؤشر) يعيدنا مجددا، إذن، الى "إيديولوجيا التنمية" التي تنحى جانبا قضايا توزيع الدخل والثروة، وعدالة هذا التوزيع، والحق في المشاركة في صناعة القرار. فكل هذه الأمور وغيرها، تحتل مرتبة أدنى في الأهمية من هدف الزيادة التي تحدث في الدخل القومي الإجمالي وفي معدلات حصة الفرد الواحد منه.
إن متابعة العقود الأخيرة لتجارب تنموية مختلفة تدلل على نتائج معاكسة، في كثير من الأحوال. وقد ثبت أن المهم ليس الارتفاع بمعدلات نمو الناتج بحد ذاته، أيا كانت طبيعة هذا الناتج، إنما الأهم من ذلك بكثير هو هيكل معدلات النمو. كما انه ليس صحيحا أن تحل قضية التوزيع من خلال قضية التنمية (أي المقاربة الكمية). فقد تحدث التنمية ولكن التفاوت يظل شاسعا، أو يزيد، بين الدخول ومستويات المعيشة. وقد دللت التجربة الملموسة أن البعد الرئيس في حل قضية التوزيع هو، في الأساس، بعد سياسي واجتماعي يعتمد على خيارات سياسية محددة.
والأهم من ذلك كله فان مجرد زيادة الدخل القومي الإجمالي، وبالتالي زيادة معدلات حصة الفرد الواحد منه، إذا تم النظر إليها بمفردها، أمر لا معنى له بالنسبة الى قضية التنمية. فقد يزيد هذا الناتج زيادة كبيرة ومتسارعة (كما يحصل عندنا خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع عوائد النفط التي تشكل الجزء الأعظم من الناتج الإجمالي) في حين تظل البنية الاقتصادية متخلفة وتابعة – رغم هذه الزيادة. فالزيادة التي حصلت في الدخل القومي عندنا لم تكن في الواقع عائدة الى تغيرات بنيوية شهدها الاقتصاد العراقي بقدر ما كانت عائدة في جزئها الأعظم أما الى زيادة تصدير النفط الخام أو الى ارتفاع أسعاره عالميا أو كليهما.
خلاصة القول، انه انطلاقا من الوظيفة الإيديولوجية لهذا (المؤشر) فانه لا يرتكن إليه في إنتاج معرفة حقيقية عن الواقع الاقتصادي – الاجتماعي وبالتالي بناء رؤية لتغيره بل على العكس من ذلك.. انه يعتم على هذا الواقع. وثمة ملاحظة استدراكية هنا هي انه يمكن القول بحصول تحسن نسبي، كما ورد في الرقم موضوع حديثا، ولكن علينا أن لا نستخلص استنتاجا متعجلا قبل التساؤل عن القوى والطبقات والشرائح الاجتماعية التي استحوذت على هذه الزيادة. وحركة الواقع الفعلي تقول لنا أن القوى المستفيدة من هذا التحسن هي قطعا ليست الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بل هم حيتان البيروقراطية والطفيلية والكومبرادورية وسراق المال العام وما يماثلهم والذين يمكن الإشارة إليهم بأصابع اليد ورؤيتهم بالعين المجردة و في وضح النهار وليس في الظلمة أو من خلال مجهر !
نحتاج إذن في واقع الأمر الى مقاربة بديلة وملموسة للواقع الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا اليوم، مقاربة لا تنشغل بلعبة الأرقام المجردة وحدها وهي لعبة مغرية للبعض على ما يبدو. إن المقاربة الملموسة للواقع الراهن تبين أن المعلم المميز للفترة الانتقالية الراهنة والتي تأتي أيضا امتدادا للفترة التي سبقتها، هو تفاقم التفاوتات الاجتماعية وتعمق الفرز الطبقي والاجتماعي وتعاظم البطالة وبمديات واسعة واتساع التهميش الاجتماعي بشكل بات ينذر بتوترات اجتماعية قد يكون من الصعب السيطرة عليها فيما لو تفجرت التناقضات المكبوتة بفعل عوامل عديدة، بعضها يقع خارج الاقتصاد طبعاً. ومؤشرنا العتيد لا يقول لنا ولا كلمة واحدة عن هذه المظاهر.. انه يصمت كصمت القبور بسبب انه يراد استخدامه كمقولة معممة تصلح لكل زمان ومكان في حين أن الصفة الأساسية لعلم الاقتصاد هو كونه علما اجتماعيا تاريخيا، وحين نستخدم مقولاته بشكل معمم فإنها تفقد صفتها العلمية، وتؤدي عندها وظيفة آيديولوجية– أي التعتيم على واقع يتمرد على الأرقام الصماء.