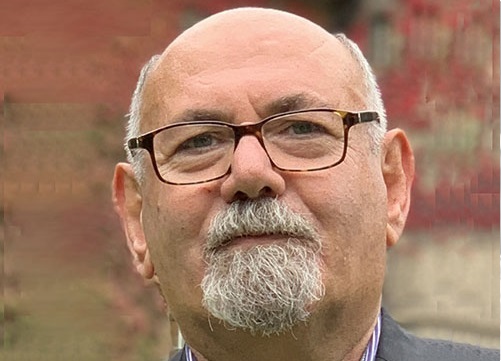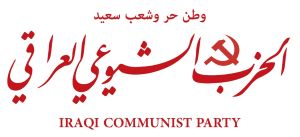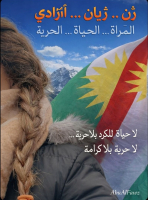كي لا يتبدد السحر الذي يسعى مفكرو الرأسمالية المعاصرة الى احاطة الليبرالية به، كان على الناس أن يغمضوا أعينهم عما ترتكبه من فظائع أو أن يجبروا على اغلاقها، كي يقتنعوا بأن سلب مكتسباتهم في دولة الرفاه وتفكيكها هو نتاج لتعطل النمو الاقتصادي وارهاق الدولة بنفقات كبيرة، وليس نتاج مشروع طبقي استغلالي، وأن يفسروا موجات الهجرة بأنها طمع "المتخلفين" في اقتسام الثروة مع "المتحضرين" وليس نتاج الحروب والنهب الأمبريالي للدول التابعة على مدى قرون، وأن لا يجدوا في الحرب الروسية الأوكرانية الا مطامح بوتين الأمبراطورية وليس نتاج حاجة العولمة المتوحشة لفرض هيمنتها كقطب بلا منافس له. إن على الناس أن يقتنعوا بما تنسبه الليبرالية لنفسها من فضائل، فكل ما يخالفها ليس سوى أضغاث تفسيرات يسارية حقودة.
حقيقة الليبرالية
يشير المفهوم الشائع لليبرالية الى أنها آيديولوجية سياسية تتبنى الحريات والحقوق الفردية ومزايا الملكية الخاصة والحد من سلطة الدولة، وتطلق المبادرة وتحرر ارادة التفكير المستقبلي والتسامح، وتحمي المواطن بسلطة القانون وتمنحه وفرة من السلع والمتع. فهل يصح هذا التعريف؟ وماذا يحدثنا التاريخ عن عتاة الليبراليين وأبائهم المؤسسين؟ وهل يمكن المساواة بين الليبرالية والحرية والتقدم؟
لقد نشأت الليبرالية حسب الفيلسوف والمؤرخ الإيطالي دومينيكو لوسوردو، مع مالكي العبيد، الذين لم يشكل التمييز بين حرية البعض وعبودية الآخرين أي غصة في حلوقهم أو تناقضاً في العقل لديهم، الى الحد الذي وجد معه جون لوك، أحد رموز الليبرالية، العبودية شيئا "بديهيا لا يقبل الجدل" بل ومارس شخصياً تجارة الرقيق بنفسه. والأمر ذاته ينطبق على جون كالهون الذي دافع بقوة عن العبودية في ولايات الجنوب الأمريكي، وعلى آدم سميث الذي دعا لحكومة استبدادية من أجل تقليص العبودية. وعليه فأن أبرز سمتين متناقضتين لليبرالية في الواقع، ولدتا معها، هما الحرية السياسية والعبودية.
ولعل من تجليات هذا الإستنتاج في التاريخ، تحرر الأمريكان من الإستعمار الأوربي في ذات الوقت الذي استعبدوا فيه السود، أو بناء الأوروبيين لثقافة العمل والانضباط والتحرر في مجتمعاتهم وهم يقومون بإستعباد شعوب الدول الضعيفة، أو قبول العمال العيش والعمل في ظروف قاسية كي يتحرروا من عبودية الريف في الوقت الذي وفروا فيه لمستغليهم الليبراليين فرصاً كي يوهموا أنفسهم بالثقة والرقي. ولهذا فالليبرالية مشروع طبقي، لا علاقة له بالمساواة، مشروع حاول مالكو العبيد من خلاله بعد أن تحرروا من السلطات التقليدية، ايكال العمل الثقيل والقذر إلى طبقة أدنى، إنها مشروع لتقسيم العالم إلى قسمين، أولئك الذين يستمتعون وأولئك الذين يعملون.
هل خدمت الليبرالية التقدم الإنساني؟
يجيب المفكرون الماركسيون بالإيجاب، فقد تجرأ الإنسان على تقمص دور الملك، ظل الله على الأرض، وفرض سيادة القانون للحد من السلطة المطلقة، مما تمكن معه العمال والعبيد اقتحام المساحة المقدسة التي اصطفاها الليبراليون لإنفسهم، ونجحوا الى حد كبير في تحقيق بعض اهدافهم في الحرية.
ولم تكن المتغيرات التي حدثت فيما بعد كإلغاء العبودية وقيام الأنظمة الديمقراطية البرجوازية وتشريع حق الاقتراع العام للجميع بما فيهم النساء وغير المالكين، متغيرات عفوية بالطبع، بل ثماراً لصراع طبقي متواصل، خاضته البرجوازية نفسها ضد الأقطاعية وضد أخطاء أطياف مستبدة منها، وخاضه جمع من المثقفين والمفكرين المنسلخين من طبقاتهم ضدها، ومنهم على سبيل المثال، اليعاقبة أبان الثورة الفرنسية وماركس وأنجلز ورفاقهما، وخاضته بشكل أساسي الطبقات المضطهدة، متحدية القوة والهيمنة، لاسيما بعد توطد الرأسمالية.
ولم يكن هذا التطور بسيطاً أو خطياً، فالليبراليون عنيدون ولا يتخلون عن موقعهم في السلطة دون قتال، بل يتمسكون بامتيازاتهم ويحشدون سلطة الدولة والجيش والدعاية لهذا الغرض. ولم يكن ظهور البيولوجيا العنصرية ومن ثم النازية والفاشية، الا صفحات في ذلك القتال ضد الحرية ونكوص مرير عن مسار التقدم، حيث أثبتت بأن حاجة الليبراليين لقمع العامل الموضوعي في الصراعات السياسية الاجتماعية، يمكن أن يعطي لآليات الصراع أوجهاً بشعة، وهو ما وجدناه أيضاً في الولايات المتحدة، حيث تزامن الاتجاه نحو التقدم الاجتماعي بالنسبة للبيض الفقراء مع اكتمال نزع الصفة الإنسانية عن العبيد السود، مما خلق عقبات هائلة أمام وحدة الطبقة العاملة في النضال للخلاص من الإستغلال.
الليبرالية اليوم
لقد واجهت الليبرالية أكبر تحدياتها في القرن العشرين مع قيام الإتحاد السوفيتي وإنشاء كتلة اشتراكية في الشرق وانتصار عدد كبير من الثورات المناهضة للاستعمار. الا أن سقوط الكتلة الشرقية منحها قدرة كبيرة على إحداث الفوضى وتكثيف المشروع الليبرالي على المستوى الاقتصادي والسياسي والأيديولوجي بحرية أكبر. كما تمكنت من الاستفادة من جهاز إعلامي متطور وهائل الإمكانيات، فيما راحت تلقي اردية داكنة على جوهر الصراع الاجتماعي، في محاولة واهمة لنسيانه أو احباطه، وتنسب لها حتى بعض الثورات الوردية، كما حدث في فوز اليساريين من غير الشيوعيين في بعض دول امريكا اللاتينية وفي اسيا.
غير أنها تدرك قبل سواها، بأن المشكلة تبقى صارخة لأن الصراع الطبقي لم يختف قط، والشيوعية لم تمت قط، والعصر الاستعماري لم ينته بعد، وما زلنا في حالة من الجمود لا مفر منها، الا بنزع القناع عن الليبرالية وبالتالي المساهمة في بناء نسخة جديدة من الماركسية، نسخة تكف عن تبرير أخطاء الماضي، لاسيما ما حدث في القرن العشرين، وتمنح علاقات الهيمنة الدولية والصراعات الثقافية مكانة ما في تحليلاتها، نسخة لا تقصر الكفاح على مفاهيم اضمحلال الدولة أو الإلغاء الكامل للسوق، بل وتجد بديلاً عن الليبرالية، يعّبد الدرب للحرية والتقدم، ويصبح من المستحيل معه قيام أي أرستقراطية في المستقبل.