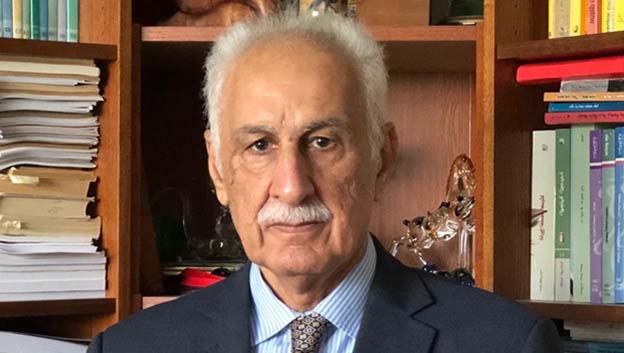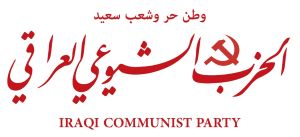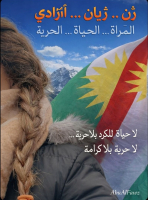مع اقتراب موعد نهاية عهد الرئيس بوش الابن في دورته الثانية كان يمكن للمتابع أن يلاحظ اندحار وتساقط العديد من رموز المدرسة التدخلية للمحافظين الجدد، وبدا الأمر ملفتاً عندما أغلقت مؤسسة القرن الأمريكي الجديد أبوابها بعد أن كانت مرتعا لشلة المحافظين الجدد، وطالت عملية الانكفاء والتراجع معظم المراكز البحثية المحافظة بعد سيطرة شبه مطلقة على الخطاب الفكري والسياسي والإعلامي في الساحة الأمريكية.
وفي هذه الاثناء انطلقت بعض المبادرات الرافضة لسيطرة المحافظين الجدد وسعت للمواجهة والتحدي حتى قبل الانتخابات النصفية في عام 2004، حيث انطلقت مجموعة وازنة في موقفها الأكاديمي والخبرة السياسية من المحسوبين على التيار الوسطى المحافظ المتمثل بـ (معهد كاتو)، والليبراليين من الحزبين من سبق لهم الخدمة في إدارات جمهورية وديمقراطية سابقة، أطلقوا على أنفسهم اسم "تحالف من أجل سياسة خارجية واقعية"، وأصدورا بيانين متلاحقين في الشهور الأخيرة من عام 2003 وقع عليهما أكثر من 50 شخصية أكاديمية وسياسية معروفة، تحت عنوانين بارزين: الأول "مخاطر الإمبراطورية"، والثاني "مخاطر الاحتلال".
وتلاحقت المبادرات الأخرى لتشكيل مراكز بحثية ومؤسسات استشارية تعبر عن التوجه الديمقراطي، وخاصة الجناح "اليساري" بالمعيار الأميركي طبعاً داخل الحزب الديمقراطي، مثل مركز التقدم الأمريكي "Center of American Progress "، ومركز الأمن الأميركي الجديد""Center for New American Security. وسرت حالة من الحيوية والانتعاش في أوصال بعض المراكز البحثية المحسوبة على الحزب الديمقراطي، وارتفعت وتيرة الانتقاد لسياسة الرئيس بوش الابن ومخاطرها في وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة.
وسارعت بعض المراكز البحثية إلى تشكيل فرق عمل مشتركة من مفكرين إستراتيجيين ومسؤولين سابقين من الحزبين، لتقديم رؤى ودراسات وبرامج جديدة تعالج مختلف الجوانب السياسية والإستراتيجية، ومن أبرز الدراسات التي صدرت عن (مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية) CSIS كانت تحت عنوان: smarter more secure America " A - أميركا أذكى وأكثر أماناً"، أو بعبارة مختصرة: القوة الذكية.
وشكلت الدراسة، عملياً، إدانة صارخة لنهج وسياسة الرئيس بوش الإبن وهي وإن تجنبت اتهامه صراحة باستخدام "القوة الغبية" إلا أنه كان واضحا من هو المقصود. وتشكل الدراسة تطويراً لمقولة "القوة الناعمة" التي أطلقها (جوزيف ناي Joseph Nye)، وهو من الذين شاركوا في صياغة الدراسة، بالإضافة إلى (Brzezinski) وريتشارد أرمتياج (Richard Armitage) وغيرهم.
وملخص هذه المقولة يشير إلى أنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تعيد إحياء قدرتها على "زرع الأمل والإقناع" حول العالم، بدلا من الاعتماد على قوتها العسكرية وحدها. فبالرغم من هيمنتها وتفوقها في امتلاك القوة القاسية أو الخشنة (Hard Power) فهي محدودة القدرة في مواجهة تحديات السياسة الخارجية. فمركز وهيبة أميركا في العالم في تلاشِ متسارع، وتجاهلت إلى حد كبير استخدام الوسائل التقليدية للقوة الناعمة (Soft Power) ، ولا تزال تفتقد إلى رؤية إستراتيجية تمكنها من مزج القوتين "الناعمة والخشنة"، وتحويلها إلى "قوة ذكية" لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويتوجب عليها اغتنام الفرصة السانحة للانخراط في حوار وطني شامل داخلي حول أفضل السبل لاجتذاب دعم أصدقائها وحلفائها في خدمة وضمان مصالحها للأمن القومي.
وباشر(مركز الدارسات الدولية والإستراتيجية) CSIS منذ صدور هذه الدراسة في عام 2007 إلى عقد سلسلة من المحاضرات الدورية تحت هذا العنوان أي "القوة الذكية". وكان ملفتاً أيضاً أن يصدر في صيف عام 2008 كتاب جديد لـ (تيد غ. كاربنتر) Ted Galen Carpenter، أحد أبرز خبراء ومحللي شؤون الأمن القومي في (معهد كاتو) تحت عنوان: "القوة الذكية: نحو سياسة خارجية حكيمة لأمريكا". ويتناول كاربنتر في هذا الكتاب بصورة أساسية مخاطر وثغرات الاعتماد الأمريكي المفرط على القوة العسكرية، ويدعو إلى ضرورة إعادة النظر بالانتشار العسكري المكلف للولايات المتحدة، ويطالب بضرورة تقليص الميزانية التي تنفقها الولايات المتحدة على الشؤون العسكرية والأمنية.
ولابد من تسليط الضوء على "مشروع إصلاح الأمن القومي Project on National Security Reform " الذي صدر التقرير الأول عنه في يوليو 2008، وشكل أهم مراجعة حول إستراتيجية وهيكلية الأمن القومي الأمريكي منذ عام 1947.
تطرح الملاحظات السابقة السؤال التالي: هل كانت إدارة (باراك أوباما) تسعى لتأسيس "مدرسة فكرية" خاصة بها، أم حاولت ان تعتمد على مدرسة من المدارس الثلاث المعروفة في التفكير الاستراتيجي الامريكي؟
يبدو ومن خلال متابعة الممارسة أن إدارة أوباما كانت أقرب في صياغتها لاستراتيجيتها المقبلة إلى المدرسة الليبرالية المثالية، مع تطوير انتقائي لها، وكانت مضطرة الى اعتماد استراتيجية تمزج بين جوانب من المدرسة الواقعية المحافظة والمدرسة الليبرالية المثالية، بواقع الاضطرار وليس الرغبة.
وكان من السهل توقع رؤية الإدارة الديموقراطية بقيادة أوباما استنادا إلى طبيعة المستشارين المتحلقين حوله إبان حملته الانتخابية الأولى، وكان أبرزهم - ولو عن بعد - بريجينسكي Brzezinski وجوزف ناي، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين حفلت بهم إدارة الرئيس كلينتون. وكان من المنتظر أن يعتمد أوباما على فريق الأمن القومي الخاص به من مسؤولين سابقين في الحزب الديموقراطي، يتوزعون على مراكز أبحاث ومؤسسات محسوبة على الحزب.
ما الذي جرى بالملموس؟ يمكن القول واستنادا الى الملاحظات السابقة بأن الأزمة المالية التي اندلعت في أيلول/سبتمبر 2008 وإعادة صياغة السياسة الخارجية الأمريكية شكّلا الميلين الاستراتيجيين الحديثين الأكثر بروزاً بعد تولي (باراك أوباما) رئاسة الولايات المتحدة. ذلك أنه منذ أن أطلقت (وول ستريت) شرارة الأزمة المالية المشار اليها أعلاه، يمكن المجادلة بأن الولايات المتحدة كانت تقف في صلب كِلا الميلين. وهذا يفسر جزئياً سبب وجود مستوى عالٍ من التفاعل بينهما.
كان للأزمة المالية، من ناحية، تأثير كابح للسياسة الخارجية لأوباما. صحيح أنه وضع أجندة طموحة للسياسة الخارجية، بيد أن معالجة الأزمة المالية والشروع في إصلاحات داخلية استحوذت على جزء كبير من اهتمامه خلال سنته الأولى في الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، عملت نتائج الأزمة المالية، مثل العجز المالي المتفاقم، وانشغال الناخبين بالقضايا المحلية، والتحولات المتسارعة للقوة نحو الشرق، على إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواصلة العمل كـ "ضامن للأمن العالمي". وقد نتج عن كل من التوجه نحو مزيد من التعاون وتبني سياسة خارجية أمريكية جامعة قرار استراتيجي بزيادة سريعة في عدد الجنود في أفغانستان، لكنّ البدء بسحبهم في وقت مبكر في منتصف سنة 2011 اضافة الى انسحاب القوات الامريكية في العراق في نهاية سنة 2011 يعكس، جزئياً على الأقل، إدراك أوباما للمحدودية المتأصلة في قوة الولايات المتحدة في فترة رئاسته. اما الميل الرئيسي الثاني فتمثل في إعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية، مكيّفاً إياها مع بيئة متغيرة، محاولا اجراء قطيعة لإرث سيء السمعة تركه سلفه (جورج دبليو بوش).
واجه أوباما تحديات معقدة ومتشابكة في السياسة الخارجية. فعلى صعيد الحربين اللتين ورثهما من بوش (في العراق وباكستان)، تميز العراق بمستقبل سياسي محفوف بالكثير من المخاطر ومفتوح على احتمالات عدة، في حين أن الوضع في أفغانستان تدهور بشكل خطير في السنين الأخيرة من دورة حكم أوباما الاولى.
كما ورث أوباما أيضاً توترات شديدة في العلاقات مع روسيا الاتحادية، ثم ان العلاقات مع الصين لم تكن خالية من التوتر هي الأخرى باعتبار أن بوش رأى في (بكين) منافساً استراتيجياً وأزعج القيادة الصينية على نحو متكرر بتعليقاته الخاصة بتايوان والديمقراطية وحقوق الإنسان. وعلى رأس كافة هذه التحديات، كانت سمعة الولايات المتحدة قد وصلت إلى الحضيض عندما تولى أوباما الرئاسة.
سعى أوباما لمواجهة كافة هذه التحديات باعتماد أسلوب جديد في السياسة الخارجية وتبنّي العديد من الاستراتيجيات الجديدة.
- على صعيد الأسلوب، تبنّى أوباما في السياسة الخارجية مقاربة approach تشدّد على قيم الدبلوماسية والمسؤولية المشتركة. فقد كرر الدعوة إلى "مرحلة جديدة من المشاركة مع العالم بناء على المصالح المتبادلة وعلى الاحترام المتبادل"، مصوّراً الولايات المتحدة كشريك بدلاً من قائد متسلّط. وبتبنّيه موقفاً واقعياً براغماتياً، دعا إلى محاورة "الأنظمة العدائية".
كما أنه طرأ تغيير على النبرة وعلى الرمزية. فقد استبدل الرئيس الأمريكي عبارة "الحرب على الإرهاب" الباعثة على الاستقطاب بخط يميل إلى مزيد من التصالح، وتطلّع إلى تقويم انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة فيما يتعلق بطرق الاستجواب. وقرر إغلاق معتقل غوانتانامو في غضون عام، برغم أن عقبات قانونية وأخرى سياسية أخّرت إغلاقه.
تجدر الإشارة أيضاً إلى تغييرين في السياسة يتعلقان بالصين وروسيا الاتحادية.
فقد سعت السياسة الجديدة التي اتبعتها إدارة أوباما مع الصين، والتي أُطلق عليها "الطمأنة الاستراتيجية"، للتعامل مع بكين كشريك عالمي وشددت الادارة الجديدة على مزايا بروز الصين وعلى الأفق الاقتصادي للتعاون الصيني - الأمريكي. وما من شك في أن اللغة التصالحية التي اعتمدها أوباما أثناء زيارته للصين في تشرين الثاني 2009 قوبلت بالترحيب في بكين.
كما أنه تم "إعادة ضبط" العلاقات مع روسيا الاتحادية بناء على عدة لقاءات ثنائية عقدها الرئيسان (أوباما) و (دميتري مدفيديف Dmitrij Medvedev) ولاحقا (فلاديمير بوتين Vladimir Putin)، وعلى المفاوضات المتجددة على ضبط التسلح، وعلى قرار الولايات المتحدة بإلغاء المكونات الأوروبية الشرقية في خططها الخاصة بالدرع الصاروخي. لكن السنوات الاخيرة شهدت ايضا بعض التوترات وتصادم المواقف بشأن جملة من القضايا الاقليمية والدولية، وتوسعا لحلف الناتو شرقا وهو الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.
بالمقابل هيمنت التحديات الجيوسياسية في جنوب آسيا وفي الشرق الأوسط على السياسة الخارجية الأمريكية. على أن مقاربات أوباما الجديدة في أفغانستان، وفي أزمة البرنامج النووي الإيراني، وفي الصراع العربي - الإسرائيلي لم تُترجَم إلى نجاح سياسي غالبا. وكانت هناك خيارات صعبة في انتظاره حيث أنه كان في حاجة إلى انتهاج سياسات توفيقية في أفغانستان وباكستان، وإلى إعادة تقييم انفتاحه على إيران، واتخاذ قرار بشأن القيام بوساطة أكثر فاعلية في صراع الشرق الأوسط. كما أن الاستعداد للانسحاب من العراق شكل تحدٍّ إضافي أيضاً. ومع ذلك بقي الأمل ضعيفا بإحراز تقدم مع ازدياد هيمنة القضايا المحلية على أجندة أوباما وخصوصا الفترة الثانية من رئاسته.