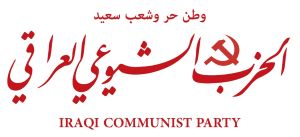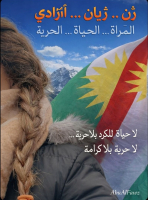تطرح علاقة الذات بالموضوع وموضوعية العالم الخارجي وما تمدنا به الحواس من معارف وما يدلنا إليه العقل، مشكلية(**) يختلف الموقف منها، بعامة، باختلاف المذاهب الفلسفية المتمحورة حول تيارَين رئيسيين في الفلسفة هما المادية والمثالية ضمنهما مذاهب واتجاهات، هنا نركز على التمييز بين مادية مبتذلة، ميكانيكية، ومادية ديالكتيكية علميَّة أرست أسسها النظرية الماركسية – اللينينية، فأسبقية الموضوع (المادة) على الذات (الوعي)، التي هي أساس التمييز بين المادية والمثالية، وأساس التمييز بين المادية الميكانيكية والمادية العلمية الديالكتيكية، ليست أسبقية ميكانيكية، أي ثنائية ذات/ موضوع، مادة / وعي، بل هي علاقة مادية ديالكتيكية. فقد أكدَ ماركس أن الإدراكات الحسية هي المصدر الوحيد لمعارفنا ولكنه تأكيد أعطى فيه البعد المنهجي الديالكتيكي بإظهاره لمفهوم التناقض بين العقلي (المحض) والتمثل الحسي للواقع في وحدتهما، أي عدم التطابق، الميكانيكي، بين العقلي والحسي بقوله “لو كان شكل تجلي الأشياء وماهيتها منطبقين بصورة مباشرة لما كان هناك حاجة إلى أي من العلوم”.(11)
وفي كتابه “لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية” أعطى انجلز البعد المتمم لمسألة أسبقية المادة على الوعي بتحديده أن “أعلى مسألة في الفلسفة بكاملها، مسألة علاقة الفكر بالكائن”، وهي المسألة التي تظهر الاضطراب في المادية والمثالية عند طرح سؤال العلاقة بين المادة والوعي التي تعني أيهما أسبق المادة أم الوعي؟ انتقدت الفلسفة الماركسية الثنائية الميكانيكية لمفهوم الأسبقية وأعطته معنى أعمق ليس من خلال تأكيد أسبقية المادة على الوعي وحسب بل من خلال، في الوقت نفسه، السير ببحث هذه المسألة بإظهار العلاقة الديالكتيكية بينهما، هنا بالتحديد تكمن أهميَّة البعد الفلسفي المادي الذي أعطته الفلسفة الماركسية لتلك المسألة، تجلى ذلك في إبراز انجلز أن “مسألة علاقة الفكر بالكائن ترتدي أيضاً مظهراً آخر: ما هي العلاقة بين افكارنا عن العالم المحيط بنا، وهذا العالم نفسه؟ وهل يستطيع فكرنا ان يعرف العالم الواقعي وهل نستطيع في تصوراتنا ومفاهيمنا عن العالم الواقعي ان نكوِّن انعكاساً صادقاً عن الواقع؟”.(12)
لينين وإظهار الجانب المتمم لمسألة أسبقية المادة على الوعي
استكمل لينين بحث علاقة الفكر بالواقع ومسألة أسبقية الواقع على الفكر وربطها بنظرية المعرفة وهو بحث ينطوي على بعد فلسفي ثوري في نظرية المعرفة (الابيستيمولوجيا) أي إظهار العلاقة بين المادة والوعي، وليس إمكان المعرفة بالمعنى المثالي المحض، بحث يتجاوز المادية الميكانيكية والمثالية، فتأكيد الماركسية – اللينينية أسبقية المادة على الوعي يلازمها الكشف عن ارتباط الوعي، ديالكتيكياً، بالعالم الموضوعي وبعملية المعرفة. لذلك اهتم لينين، في ضوء المنهجية المادية الديالكتيكية، بالعلاقة بين المادة والوعي، وهي مسألة فلسفية تقع في صلب نقد لينين للمذاهب المثالية وللمادية الميكانيكية.
في بحث لينين لمسألة أسبقية المادة على الوعي والتضاد بينهما أظهر الجانب المتمم لها بتحديده “أن التضاد لا يتسم أيضاً بأهمية مطلقة إلا ضمن حدود ميدان ضيق جداً: في الحالة المعنية، ضمن الحدود التالية بوجه الحصر، حدود المسألة العرفانية [نظرية المعرفة] الأساسية المتعلقة بما يصح اعتباره الأولي وما يصح اعتباره الثانوي، وفيما وراء هذه الحدود، لا مجال للشك في نسبية هذا التضاد”،(13) وبالتالي فإن التضاد بين المادة والوعي، يعني أن التضاد بينهما لا ينفصل عن وحدتهما، حتى وإن افترض أسبقية المادة في إظهار هذه الوحدة، انطلاقاً من أن التركيز على التضاد بين المادة والوعي يؤدي إلى الثنائية التي تنقضها الماركسية – اللينينية في منهجيتها المادية الديالكتيكية، التي تنفي التناقض على قاعدة حله ديالكتيكياً. بهذه المنهجية نقدَ لينين سعي ما سمي “الخط الثالث” للجمع ما بين المذهب النقدي التجريبي والماركسية، نقد خصص له الفصل السادس “المذهب النقدي التجريبي[الامبيريقي] والمادية التاريخية” من كتابه “المادية والمذهب التجريبي [الامبيريقي] النقدي”، مؤكداً في خاتمته أنها محاولة لا يمكن أن تتم إلا في حال “الجهل المطبق بصدد ماهية المادية الفلسفية على العموم وبصدد ماهية طريقة ماركس وانجلس الديالكتيكية”.(14)
إذن، بإظهار العلاقة الديالكتيكية لصراع الأضداد ووحدتها تنتفي الدغمائية، وينتفي الفصل الميكانيكي بين الأضداد الذي يوقع في الثنائية، وبالتالي ليست كل مادية هي، بالضرورة، مادية علمية ديالكتيكية. لذلك أولى لينين، في ضوء المنهجية المادية العلميَّة، اهتمامه للعلاقة الديالكتيكية بين الوعي والمادة.
علاقة البراكسيس بالفكر وفهم الواقع من أجل تغييره
انطلاقاً من المفهوم المادي الديالكتيكي لأسبقية الواقع على الفكر وارتباطها بالبراكسيس يتضح معنى فهم الواقع من أجل تغييره وعلاقته بالبنيَّة الاجتماعية التي أنتجته، وهنا تتضاعف ضرورة تحديد، بعجالة سريعة، علاقة البراكسيس بالفكر، المعرفة، التي يكثر تشويهها، لإظهار وكأن الماركسية تقول بأسبقية تغيير الواقع على فهمه، فعلاقة البراكسيس بالفكر، بمفهومها الماركسي – اللينيني، نقيضة لمحاولات تشويهها، إنها علاقة اتصال / انفصال ديالكتيكية في وحدتهما، وهذه العلاقة ما لا يدركها الفكر الميكانيكي والمثالية، فالبراكسيس يعني نشاط الإنسان وتطور معرفته بالواقع، أي له أسه التاريخي، إنه نشاط متعلق بالصراع الطبقي وإنتاج نظريته من أجل التغيير، وأن تطور معرفة الإنسان بالواقع تغني ممارسته من أجل التغيير. فالفكر يبقى “حبيس عقمٍ مملّ طالما لم ينفتح، في نشاطه النظري، على الممارسة التحويلية للعالم كحقل استقصاء خاصٍ به. فإن لم يرتبط في مصيره مع الإنسان الذي يصارع كل قوى ”الإنسان“، لكي تنتصر في النهاية الحرية والعقلانية، يحكم الفكر بالعدم، وبأن يكون صوتاً بلا صدى، وكلمة فارغة من المعنى، معنى أن تصبحَ فِعلاً”. (15)
إنها المنهجية المادية الديالكتيكية للعلاقة ما بين الفكر والواقع والبراكسيس في صيرورة واحدة انتقدت فيها مقولة مثالية شائعة تهدف إلى حرف التغيير عن أرض الواقع المادي، وهي الترويج لحصره في تغيير المفاهيم، أي مقولة تستبدل العالم المادي بالعالم الميتافيزيقي، ترتكز نقطة نقد تلك المقولة المثالية بأن المفهوم المادي للتاريخ يبقى على أرض الواقع وهو “لا يفسر الممارسة انطلاقاً من الفكرة، بل يفسر تكون الأفكار من الممارسة المادية، وفقاً لذلك، فإنه ينتهي إلى الاستنتاج بأن سائر أشكال الوعي ومنتجاته يمكن حلها ليس بالنقد الذهني، بالانحلال في ”الوعي الذاتي“(…)، بل فقط بواسطة القلب العملي للعلاقات الاجتماعية المشخصة التي ولد منها هذا الهراء المثالي، وإن الثورة لا النقد هي القوة المحركة للتاريخ”(16).
يحمل النص، في جزء منه، أهمية مركزية في تحديد المفهوم المادي للبراكسيس وارتباط الوعي بالواقع المادي وشروطه، في مواجهة المفهوم المثالي وأيديولوجية الطبقة البرجوازية المسيطرة، أي كيف يصبح النتاج الثقافي قوة مادية في عمليَّة النضال التي تخوضها الجماهير، التي تعي ضرورة التغيير الديمقراطي وشروطه المادية التاريخية والتحرر الوطني وكسر علاقة التبعة بالنظام الرأسمالي الامبريالي وأيديولوجيته، ويبقى حدها المعرفي الفاصل الموقع الطبقي، موقع البروليتاريا، النقيض لموقع الطبقة البرجوازية المسيطرة وأيديولوجيتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش
(**)مشكلية جمعها مشكليات. “المشكلية هي الوحدة الفكرية لعدد من المشكلات التي يربط بينها كونها لا يمكن طرحها إلاّ في إطار محدد هو إطار المشكلية الواحدة، وبالتالي على تربة فكرية واحدة”. عامل مهدي، في الدولة الطائفية، لا. ط، دار الفارابي، بيروت، 1986، ص.150. هامش رقم 81. على هذا الأساس هناك ضرورة للتمييز بين مشكلية وإشكالية لاختلاف معناهما وحكاية الاختلاف بينهما “أن اللفظ الألماني problematik دخل إلى الفرنسية بعد تعرفها هوسرل والتبس مع النعت الفرنسي problématiqe الذي يعني في التداول العادي ”مشكوك فيه“ أو ”إشكالي“(…)، ومع هوسرل يعني الاسم problematik الوجهة التي ضمنها تطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضوع ما”. وهبه موسى، المصطلح الفلسفي بالعربي كمشكلة فلسفية، ممارسة الفلسفة في لبنان كتّاب، نصوص، اتجاهات، تقاليد، إعداد وتقديم نادر البزري، ط1، دار الفارابي، بيروت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت، كانون الثاني 2017، ص. 174.. وقد ترجمه مهدي عامل بـ “مشكلية”، ليخلصه بحسب تحديد موسى وهبه من الإشكال واللبس، أما هو فيقول أنه أداه “بكل بساطة باللفظ: ”مسألة“، فأقول ”مسألة البحث“”. وهبه موسى، المرجع نفسه والصفحة نفسها. وهناك من يترجم المصطلح بـ مسألية.
(11) جماعة من الأساتذة السّوفيات، موجز تاريخ الفلسفة، ترجمة وتقديم: توفيق سلوم، ط 1، دار الفارابي، بيروت، 1989، ص.430.
(12) انجلس فريدريك، لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية، دار التقدم، موسكو، لا. ط، لا. ت. ص. 20.
(13) لينين فلاديمير، المختارات، 10 مجلدات، ترجمة الياس شاهين، دار التقدم، موسكو، .1978.مج4، ص. 185.
(14) المصدر نفسه، مج4، ص. 460.
(15) عامل مهدي / حسن حمدان، البراكسيس والمشروع، مبحث في تكوينية التاريخ، ترجمة عبد الله ميشال غطاس، مجلة الطريق، بيروت، العددان 28- 29، السنة 78، شتاء 2019/ ربيع 2019، ص. 48. مقدمة أطروحة الدكتوراه التي ناقشها حسن حمدان / مهدي عامل، سنة 1967 في جامعة ليون – فرنسا، تحت إشراف هنري مالديناي.
(16) ماركس كارل، انجلز فريدريك، الايديولوجية الألمانية، مصدر سابق، ص. 62.
* سكرتير تحرير منصة (تقدم)
منصة (تقدم) – 27 أيلول 2024