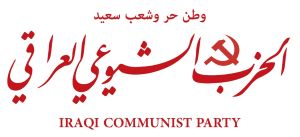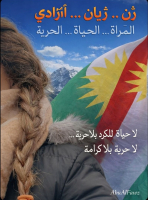التقييم الدقيق للأرقام ليس مسألة فنية فحسب، بل يشكل محوراً سياسياً حاسماً في فهم طبيعة الانتخابات، لأن العملية الانتخابية في جوهرها لعبة أرقام تصنع الشرعية وتعيد إنتاج النفوذ. والطغمة الحاكمة تدرك ذلك جيداً، سواء على مستوى صناعة المشروعية أو على مستوى التأثير السياسي والمعنوي، ولهذا تعمدت المفوضية رفع نسبة المشاركة بما يخدم مصالح هذه الطغمة، ويمنحها غطاءً شعبياً مصطنعاً. ومن هنا تأتي أهمية قراءة الأرقام علمياً، لأن الصراع مع الطغمة لا يُحسم بالشعارات، بل بمنهجية تفكك روايتها الرقمية وتكشف زيفها. وبالنظر إلى أن الأرقام المستخدمة في هذا التحليل هي أرقام المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات، فإن الاحتكام إليها يكشف حجم الخلل، رغم أن أعداد المراقبين الحقيقيين تجاوزت بكثير ما أعلنته المفوضية، خصوصاً أن تضخم أعدادهم انحصر في الوسط والجنوب، بينما لم يشهد إقليم كردستان أي ارتفاع مشابه، ما يدل على أن هذه الأرقام صُممت لأغراض تعبوية لا انتخابية.
مفارقة النِّسَب… المفوضية تُعلن والمراقبون يَدحضون
أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة بلغت 56%، وهو رقم أثار سخرية واسعة بين المواطنين، لاقترابه من دلالة قانونية ترتبط بالنصب والاحتيال. ولتفكيك كيفية الوصول إلى هذه النسبة، يجب تحليل المعادلة التي استخدمتها المفوضية: فهي تحتسب المشاركة عبر قسمة عدد المقترعين (12,009,453) على عدد المسجلين بايومترياً فقط (21,416,335) وهي معادلة تخالف تماماً المعايير الدولية المعتمدة.
كان الأجدر بالمفوضية اعتماد المعادلة التي اتبعتها شبكات المراقبة العراقية، والتي قامت على قسمة عدد المقترعين (12,009,453) على العدد الكلي للمواطنين الذين منحهم الدستور حق الانتخاب (29,262,288) وفق المادة 20 من دستور عام 2005. وبهذا تكون المعادلة على النحو الآتي:
12,009,453/29,262,288=41% وهذه هي النسبة التي أعلنتها شبكات المراقبة العراقية استناداً إلى أرقام المفوضية نفسها.
الفجوة بين الأرقام الرسمية والمشاركة الفعلية بالعودة إلى الأرقام التي اعتمدتها المفوضية:
الأول: (12,009,453) وهو مجموع عدد المقترعين في التصويت العام والخاص.
الثاني: (21,416,335) وهو عدد الناخبين المسجلين بايومترياً فقط.
هذان الرقمان يتطلبان تحليلاً ورأياً واضحاً بشأنهما، لأنهما مُغلفان ببعد سياسي هدفه الواضح زيادة نسبة المشاركين على حساب نسبة المقاطعين، وإضفاء مشروعية على طغمة الحكم. غير أن تفكيك الرقمين وتحليلهما من زاوية صدقية المشروعية التي تسعى الطغمة لإظهارها يكشف ما يلي:
أولاً: الرقم (12,009,453)، الذي يمثل مجموع المقترعين في التصويتين العام والخاص، يتضمن فئات متعددة لا يمكن احتسابها كأصوات انتخابية ذات إرادة سياسية واضحة. فأعداد الذين أبطلوا بطاقات الانتخاب بلغت (729,933) ناخب، وفق المفوضية.
ثانياً: أعداد وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين بلغت نحو (2,250,000) وفق مصادر مستقلة، وهو رقم هائل لم تستطع المفوضية إنكاره بالكامل، واضطرت إلى الاعتراف بـ (1,450,000) مراقب ووكيل. وهذا العدد، على ضخامته، لم يشهده أي بلد ديمقراطي منذ اعتماد الانتخابات وسيلة لتمثيل المواطنين في المجالس التشريعية. وسيجري لاحقاً تحليل التأثير السلبي لهذا الرقم على سير عملية الاقتراع وحيادها.
ثالثاً: أعداد المصوتين في التصويت الخاص بلغت (1,084,289)، وهم ناخبون صوتوا تحت الانضباط المؤسسي الصارم الذي يحد عملياً من حرية الاختيار، ويمثل وزناً انتخابياً مُنظماً داخل البنية الرسمية. وبحاصل جمع هذه الأرقام، تكون النتيجة (4,784,289) صوتاً، تمثل مجموع أصوات الانضباط المؤسسي، والناخبين الذين أبطلوا ورقة الاقتراع، وأصوات الشراء التي جرى تمريرها تحت عنوان “الرقابة” على الانتخابات.
ولو طرحنا هذا الرقم، وهو حصيلة ترتيب مسبق وشراء أصوات وتزييف إرادة وانضباط مؤسسي، من العدد الكلي للمقترعين، فستكون النتيجة:
12,009,453-4,784,289= 7,225,164 ناخباً فقط
وعند احتساب نسبة المشاركة وفق هذا الرقم، تتضح الصورة الحقيقية على النحو التالي:
7,225,164/29,262,288=24% أي اربعة وعشرون بالمئة فقط، وهي النسبة التي تفضح مشروعية الطغمة وتكشف هشاشة السردية الرسمية حول المشاركة.
أما إذا طرحنا من حساب المقترعين مليوني صوت تقريباً، تمثل قواعد المتحزبين والمنتفعين المرتبطين بالأحزاب العشرة المتنفذة في العراق، فإن عدد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم بقناعة حرة، دون إكراه، ودون تجييش مصلحي، ودون بيع وشراء أصوات، ودون تصويت بانضباط مؤسسي، يصبح:
7,225,164-2,000,000 =5,225,164 صوتاً فقط.
وهذا الرقم يمثل الكتلة الحقيقية للناخبين الذين صوتوا بإرادتهم الفردية المستقلة، بعيداً عن شبكات النفوذ والمال والولاء التنظيمي.
وعند تطبيق المعادلة:
5,225,164/ 29,262,288 = 18%
تظهر نسبة المشاركة الفعلية انها لا تتجاوز ثمانية عشر بالمئة، وهي النسبة التي تفضح الشرعية الزائفة، لأنها تمثل فقط المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم بحرية، دون مؤثرات أو ضغوط أو شراء أو انضباط مؤسسي.
مجموع أصوات الطغمة ونسبتها تحت المجهر
وإن لم تكن هذه المعادلة كافية لكشف ضعف المشروعية التي سعت الطغمة إلى تصنيعها، يمكن اعتماد معادلة أخرى أكثر وضوحاً: احتساب مجموع الأصوات التي حصلت عليها الطغمة من التصويت العام والخاص، والذي بلغ ــ بحسب ما أعلنته المفوضية ــ (4,008,481) صوتاً. وهذا الرقم هو مجموع أصوات الفائزين في الانتخابات، متضمّناً أصوات من صوّتوا تحت الانضباط المؤسسي الصارم، والأصوات المشتراة باسم “المراقبين”، ومتحزّبيهم بطبيعة الحال، إضافة إلى ما توفره تلك الشبكات من طرق وآليات أخرى. وحين نحسب المعادلة وفق ما ارتأته المفوضية، أي اعتماد عدد المسجلين بايومترياً (21,416,335) أساساً لاحتساب نسبة المشاركة، تكون النتيجة:
4,008,481/21,416,335= 19%
هكذا هي النسبة التي لا تتجاوز تسعة عشر بالمئة فقط، التي مكنت 329 نائباً من الحصول على شرعية حكم تمثل في حقيقتها واحداً وثمانين بالمئة من شعب لم ينتخب هؤلاء النواب.
مع ان المعادلة الاصح هي مجموع اصوات الفائزين تقسم على مجموع الذين يحق لهم التصويت وفق الدستور وتكون كالتالي
4,008,481/29,262,288=13%
أي أن الفائزين حصلوا على ثلاثة عشر بالمئة فقط من أصوات من يحق لهم الانتخاب، وهي نسبة مشروعيتهم الحقيقية، مقابل سبعة وثمانين بالمئة من المواطنين لم يصوّتوا لهم ولم يمنحوهم ثقتهم.
إن تطبيق هذه المعادلات يكشف أن الشرعية التي حاولت الطغمة تثبيتها عبر أرقام المفوضية لم تكن سوى بناء رقمي مُصطنع، ينهار عند أول اختبار علمي. فعندما لا تتجاوز نسبة من صوتوا بإرادة حرة 19%، وعندما لا يحصل الفائزون إلا على 13% من أصوات من يحق لهم الانتخاب، يصبح واضحاً أن ما جرى ليس عملية ديمقراطية، بل إعادة تدوير لمنظومة النفوذ عبر أدوات رقمية وخطابات إعلامية مضللة.
هذه الأرقام لا تفضح فقط ضعف المشاركة، بل تكشف المعمار السياسي للسلطة: كتلة صغيرة مُنظمة ومسلحة بالمال والسلاح والولاء المؤسسي، مقابل مجتمع واسع مُقصى، مُنهك، أو مُخدوع بحرب الأرقام. لذلك، فإن الطغمة لا تعتمد على الإرادة الشعبية، بل على معادلات مصنوعة تَمنح الشكل دون المضمون، والشرعية الشكلية دون الثقة الحقيقية.
إن كشف هذا التلاعب لا يُعالج فقط قراءة الانتخابات، بل يفتح السؤال الأعمق: كيف يمكن لقوى مدنية مشتتة ومحرومة من أدوات النفوذ أن تواجه منظومة تُعيد إنتاج ذاتها بهذه الدقة؟ وكيف يمكن للمجتمع أن يستعيد دوره في ظل قانون انتخاب يُفصّل على مقاس السلطة، ومفوضية تدار بعقلية المحاصصة، وأرقام تستخدم كسلاح سياسي؟
هنا تتضح ضرورة التحليل العلمي: ليس لتفنيد سردية الطغمة وحسب، بل لبناء وعي سياسي يدرك أن الصراع على الأرقام هو ليس صراعاً شكليًا بل صراعاً على المعنى، على من يملك حق تعريف الشرعية، وبين شرعية مفروضة من أعلى وشرعية متولدة من الناس، يصبح المستقبل مرهوناً بقدرة المجتمع على تحويل هذه الحقائق إلى قوة فعل، لا مجرد نقد.
إن الأرقام، حين تفكك بهذه الطريقة، لا تستخدم لتسجيل نقاط في سجال حسابي، بل لكشف البنية التي تعمل من خلالها الطغمة لإنتاج شرعية شكلية لا تستند إلى الإرادة الشعبية. فالأرقام هنا ليست تفصيلاً تقنياً، بل أداة نفوذ تعيد بها السلطة رسم الواقع على مقاسها، عبر تضخيم المشاركة وتحويل المقاطعة الواسعة إلى قبول شعبي مزيف. والقراءة العلمية الدقيقة للبيانات الانتخابية تفضح هذه الآليات، لأنها تكشف الفجوة الهائلة بين الواقع وما تحاول السلطة تسويقه، وتعيد الاعتبار لمفهوم الشرعية بوصفه تعبيراً عن إرادة حرة، لا معادلة مفبركة تدار في غرف مغلقة.
وحين يتضح أن أكثر من ستة ملايين صوت تدار داخل منظومات النفوذ، مقابل بضعة ملايين فقط صوتوا بإرادتهم الحرة، يصبح الحديث عن انتخابات تنافسية أو تمثيل حقيقي نوعاً من العبث السياسي. فارتفاع نسبة المشاركة المعلنة فوق الحقيقة الرقمية لا يعود إلى خلل إجرائي بسيط، بل إلى اختلال عميق في بنية النظام السياسي نفسه، وفي فهمه لمفهوم الشرعية ومصادرها وحدودها.
ومثل هذا التحليل لا يقف عند حدود التشخيص التقني، بل يفتح الباب أمام أسئلة أعمق تتجاوز العملية الانتخابية إلى بنية القوة في العراق: كيف يمكن لقوى مدنية مشتتة ومقموعة ومحدودة الأدوات أن تواجه منظومة تمتلك المال والسلاح والإعلام والمؤسسة؟ وهل يمكن للانتخابات، بصيغتها الحالية، أن تكون طريقاً للتغيير، أم أنها أصبحت إحدى أدوات إعادة تدوير النفوذ؟ وأين يقف المجتمع العراقي، بقيمه واحتياجاته وأزماته، في هذه المعادلة المختلة؟
إن إدراك هذه الحقائق لا يقود إلى اليأس، بل إلى إعادة بناء الوعي السياسي على أسس واقعية: كشف التلاعب، وتحليل البنية، وتحديد ساحات الفعل الممكن. فالطغمة قد تملك الأرقام، لكنها لا تملك الحقيقة، وقد تملك أدوات النفوذ، لكنها لا تستطيع أن تمنع مجتمعاً حياً من استعادة أدواته حين تتوفر الشروط. ولهذا فإن فهم الأرقام ليس نهاية التحليل، بل بدايته: بوابة لفهم أعمق للصراع، ولإعادة تعريف دور المجتمع والقوى المدنية في لحظة مفصلية كهذه. والتاريخ يشهد على ان الاقلية او الاكثرية ليس كتل كونكريتية صلدة، بل ما كان اكثرية سيصبح اقلية ذات يوم والعكس صحيح بالنسبة للأقلية... والتاريخ لا يمكن ان يكون شاهد زور!