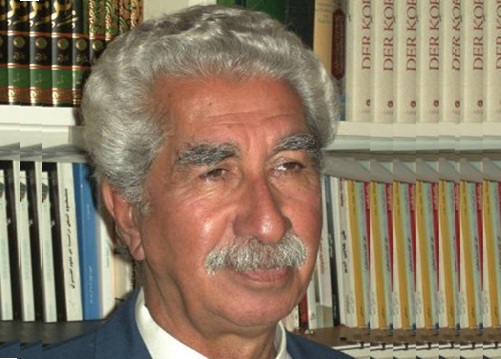
لم تترك الكتب المقدسة في الاديان مسألة العنف على النطاق النظري، بل طلبت نفس هذه الكتب ممارسة العنف تجاه الآخر المختلف كأمر إلهي مقدس لا يجوز إهماله او التباطؤ في تنفيذه. هذا النص" الصفحة 15 ـ 16 " من الكتاب اعلاه دليل على ما نقول، كمثال لكثير من الأدلة المشابهة:
"" إذا حاول اخوك ابن والدك، او ابن والدتك، او أبنك، أو ابنتك، او زوجك الذي تحب، او صديقك الحميم ان يغريك سراً بالقول "دعنا نذهب ونخدم آلهة اخرى"، آلهة لم تعرفها ولم يكن يعرفها اجدادك من قبل، آلهة الناس المحيطين بك، سواءً أكانوا قريبين او بعيدين، وفي اي بقعة كانت من العالم، فلا يجب عليك القبول، ولا الإصغاء له، يُمنع عليك التعاطف معه، عليك ألّا ترحمه او تخفي ذنبه. كلا، بل يجب ان تقتله، يجب ان تكون انت مَن يسدد الضربة الأولى لقتله ثم تتبعك أيادي الآخرين. عليك ان ترجمه حتى الموت، لانه حاول تضليلك عن إلهك يهوه "" (سفر التثنية التوراتي 13: 7 ـ 11)
لم يكن هذا النص اليهودي المسيحي، النص الوحيد الذي يدعو الى قتل الآخر المختلف، بل ان التوراة مليئة بذلك. واقول المسيحي ايضاً وذلك للأسباب التالية:
اولاً: كل كتب الاناجيل المسيحية تتصدرها اصححات التورات بكتب موسى الخمسة والمزامير التي تعتبرها المسيحية جزءً من تراثها واساساً لأنطلاق المسيحية منها. اي انها تعترف بمضامينها كجزء من العقيدة المسيحية.
ثانياً: الأنجيل يذكر بكل وضوح قول عيسى الذي صرح فيه قائلاً:" «لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ." إنجيل متى (5 :17) وهذا يعني ان عيسى لم يأت ليلغي النص التوراتي، بل ليكمله.
تأكيداً لما يجري التطرق اليه دوماً على ان الأديان الثلاثة المسماة بالإبراهيمية، اليهودية والمسيحية والإسلام، تنتمي الى تعاليم نفس المصدر الذي هو ابراهيم، او ما يُطلق عليه ابو الأنبياء، نذكر هنا النص الإسلامي الذي لا يختلف عن النص اعلاه في محتواه، وإن اختلف عنه في صياغته اللغوية او في اشخاصه المنعنيين، اما المضمون وهو قتل الآخر المختلف فنفسه:
"فإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم" [لتوبة:5].
المحطة الأولى: السمة المشتركة التي رافقت هذه الأديان وغيرها من الأديان الأخرى والتي كانت تشكل سمة عصرها بين المختلفين في الدين او القومية او على الأرض هي سمة القتل. وهذا ما تعبر عنه اكثر النصوص الدينية التي تنحو صوب العنف في التعامل مع الآخر المختلف.اي انها عكست بيئة المجتمع الذي وُجدت فيه، رغم سوءها، ولم تصلحها كما تزعم الأديان بانها جاءت لإصلاح المجتمعات. لقد اعطت هذه الاديان الآخر المختلف صفات وتسميات كالهرطقة والكفر والسحر والإلحاد وغيرها من المصطلحات التي ارادت من خلالها إعطاء جريمة القتل التي يمارسها القائمون على الدين صفة القدسية باعتبار ان هؤلاء الآمرين بالقتل يطبقون ما وصلهم من إلههم سواءً وحياً كان هذا التواصل او إيحاءً او حتى تفسيراً او تأويلاً لبعض المعتقدات الدينية.
المحطة الثانية التي يمكن استنباطها من هذه النصوص هي الحقيقة التي اجبرت المتطرفين والمعتدلين في هذه الأديان على السواء على الإعتراف بما افرزته الحضارة الإنسانية من تطور في العلوم وبعدٍ في الإكتشافات الكونية وتقدمٍ في الفكر التنويري وتأثير ذلك على عدم إمكانية تطبيق كثيراً من النصوص الواردة في مصادر اديانهم ونفور البشرية من الممارسات اللاإنسانية تجاه الآخر المختلف.
فالصهيونية العالمية التي تربط وجود وتوسع كيانها على ارض فلسطين بنصوص توراتية تبرر لها قتلها لغير اليهود على ارضها او تهجيرهم بهدم منازلهم وإحراق اراضيهم الزراعية ومطاردتهم واعتقالهم وتعذيبهم، رمت بنصوص توراتية اخرى عرض الحائط حينما تطلب امر استمرار هذا الكيان في الوجود السياسي المتجاوب مع تطورات الحداثة، كالموقف من المرأة مثلاً الذي لا يختلف في احتقاره لها عما ورد في الكتب الدينية للأديان الاخرى المسيحية والإسلام، إلا ان حرية المرأة في هذه الدولة لا تختلف كثيراً عن حريتها وحقوقها عما هي عليه في المجتمعات الحديثة المرتبطة بحضارة اليوم والتي لا تجري ادارتها من خلال المصادر الدينية.
وكذلك الأمر بالنسبة للمسيحية التي استغنت عن كل ما جاء برسائل بولس حول المرأة المسيحية وطريقة حياتها ومجمل تصرفاتها سواءً في المجتمع او في محلات العبادة.
ولا يختلف الامر بالنسبة للإسلام الذي اجبرته تطورات الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية على التخلي عن التعامل مع غير المسلمين، سواءً من اهل الكتاب او غيرهم، بفرض ما يسمى بالجزية التي لم يعد استيفاؤها ينسجم وقوانين العلاقات الدولية والعلاقات الإجتماعية في اي مجتمع من المجتمعات العربية الإسلامية. وكذلك الأمر بالنسبة لمفهوم ملك اليمين او غزو البلدان الأخرى واخذ الغنائم وغيرها، بالرغم من وجود اشارات كثيرة الى هذه الأمور في مصادر الدين الإسلامي الأساسية.
إن الدروس التي يمكننا ان نستوحيها من كل ذلك تتعلق بالسؤال حول الإصلاح الديني، وماذا نعني بالإصلاح؟
المعنى اللغوي لمفردة الإصلاح يشير الى عملية تغيير ما تم إثبات خطئه او خطأ تطبيقه ووضع البديل عنه، إن كان المجتمع بحاجة فعلاً الى بديل يتعلق بموضوع الإصلاح. وهذا يثير كثير من التساؤلات:
اولها: هل يعني ذلك ان الكتب المقدسة جاءت بأشياء خاطئة يجب تصحيحها اليوم؟ اي هل ان واضع هذه الاشياء الخاطئة لم يكن يعي خطئها اثناء تطبيقها او بعد فترة من تطبيقها، طالت هذه الفترة ام قصرت؟
ثانياً: إذا كان الأمر كذلك فما اهمية وجود هذه النصوص التي اثبت الزمن خطئها كتعاليم لا زالت تكتسب صفة المقدس ويجري تناولها وتدريسها وتحريم المساس بوجودها اصلاً.
ثالثاً: هل ان تطبيق هذه النصوص كان صحيحاً في فترة زمنية معينة وفاشلاً في فترة زمنية اخرى؟ وهذا مما يولد مناقشة ما يمكن ان يكون عليه المستقبل، وهل هذه النصوص التي بين ايدينا اليوم صالحة لتخطيط بعيد المدى ؟
رابعاً: من المسؤول عن الإصلاح؟ هل القائمون على الدين انفسهم؟ وهل يجرأون على ذلك امام جماهيرهم التي ستضع كثيراً من علامات الإستفهام على الثقة بهم ومن ثم التعامل معهم لو اقدموا على اية خطوة بهذا الإتجاه؟ او ان السلطة السياسية التي يهمها السلام الإجتماعي ومواكبة التطور العلمي والإقتصادي والثقافي وما ينجم عن كل ذلك من علاقات بين المجتمعات المختلفة وتبادل القيم الحضارية بينها؟
فمسألة الإصلاح الديني مرتبطة بخطوات تتطلب الجرأة على الإعتراف بالخطأ النظري والعملي لما يراد اصلاحه، والجراة على تنفيذ الإصلاح بالإلغاء او التعديل او التحوير بما ينسجم والتطور الحضاري الذي يرفض كثيراً من الممارسات التي تؤكد عليها الكتب المقدسة للأديان.









