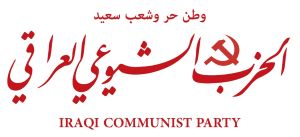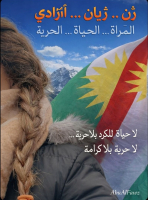1
” قسيب” و” قلالي”، كتابان متلاصقان في كتابٍ واحدٍ للشاعر والناقد / مقداد مسعود /. حملَ الغلاف الأمامي التسمية الأولى والغلاف الخلفي حملَ التسمية الثانية. الكتاب الأوّل يُقرأ بتقليب الصفحات بالطريقة المعتادة، أمّا الثاني فلا بدَّ من قَلْبِ الاتجاه، وهذه طريقة لها فرادة في تجاوز شكل الأعمال الكاملة أو تقسيم الكتاب إلى فصلٍ أوّل وثانٍ.
من معاني (قسيب) الرجل الطويل الصَلْب أو الماء الذي يحمل أوراق الشجر ويتدفق بقوّة، كما أنَّ (قلالي) تعني: المكان المرتفع، عكس الكثرة، قرية في البحرين. ويمكن تأويل بعض هذه المعاني بإحالتها إلى كيان الشاعر/ الناقد، جسمانيّاً ومعرفيّاً.
الكتابان حملا التجنيس: وحدات شعرية، ومثل هذا التجنيس هو الآخر لهُ فرادتهُ في التوصيف، واحترازهُ من إشهار علانية القول: شعر أو قصائد. ويتّضح ذلك في التقديم:
هي محاولة في التجريب.. أثنيّة إبداع، تجريبيّتي هذه، حاضنة لا جناسيتين.. إجناسيّة سرد تتفرّع من وحدات صغرى تتنمّل منها الوحدة الكبرى، وإجناسيّة شعر: دخلت صيرورة تحرر شئنا أم أبينا منذُ فجر أربعينات القرن الماضي، لا يخلو الأمر من صعوبات شعرتُها ...، أنا الملول من الإقامة في جنس أدبي واحد والمشدود لتناول العالم شعرياً.
الوحدات الشعرية في الكتاب الأوّل تحمل الترقيمات من 77 إلى صفر، أما الكتاب الثاني فمن 1 إلى 77، ويُحتمل أن تكون هذه الترقيمات إشاراتِ وقائعَ تشير إلى سنوات العمر وما رافقها من تعارضات حياتيّة.
2
الوحدات الشعرية كُتبت على طريقة الشكل الأوّل لقصيدة النثر، ألا وهوَ الشكل الأفقي وبسياقٍ سرديٍّ على الأعم. وفي كلِّ هذه الوحدات لا يلتفت الشاعر إلى الدهشة التي يأتي بها الشعر في توصيفهِ الأساس: بناءً، صورةً، إيحاءً، تشكيلاً، رمزيّةً. لأنّهُ في موقفٍ نثريٍّ سرديٍّ يُراود ما هو فكري وفلسفي ووجودي تخاطري، وهنا يذهب (الشعر- النثر) إلى المعنى، وتُختزلُ الشعريةُ بدرايةٍ معرفيّةٍ في هذا المعنى الذي يستعصي على (الحسيّة الظاهرة) طامحاً بحسيّةٍ أقرب إلى (الباطنيّة) الغامضة، وهنا يصحُّ قولهُ: الأمر لا يخلو من صعوبات شعرتُها، في هذا التشكيل النثري / الشعري / السردي.
إنَّ التجريبَ بمثل هذه السعة عصيُّ على المدركات الحسيّة، وهو الآخر يعلن بوضوحٍ فنيٍّ عن هذا التجريب: ها أنا أضفرُ من السرد وحداتهُ ومن الشعر موسيقاه الجوّانيّة على قدر خبرتي، وها هيَ أرغفتي لمن شاءَ على هيأةِ وحداتٍ شعرية. وهكذا يطمح الشاعر إلى تذوّقٍ خاصٍ لوحداتهِ الشعريّة (وها هيَ أرغفتي لمن شاءَ). والتذوّق الخاص دلالة علانيّة على خصوصيّةٍ - نثريةٍ شعريّةٍ سرديّةٍ - كامنةٍ وظاهرةٍ في الوقت ذاته. كامنة في عمقٍ تكويني، فكري وفلسفي، وظاهرة في مغايرة الشكل السائد (أنا الملول من الإقامة في جنسٍ أدبيٍّ واحد) ....:
منذُ ..............،
وأنا بنصفِ وجهٍ، أتأملُ في عناصر الأشياء، أشعرني أخترقُ ريحاً شائكة، فالتي انفثأت هي لحظة سأطلقُ عليها (لا أدري)، لن أُضيفَ للمشهدِ ما يجعلهُ مثيراً للشفقة. أتركُ الأمرَ لذوي الاختصاص، فهؤلاء سيطبعونَ نسخةً لا تشبهُ الأصلَ إطلاقاً، مثلَ جندي متهيئ للقتال، مثل بيجاما يساري تحتَ بنطلونه في مواسم المداهمات ......، مفاجأة تفوّقتْ على الغجر في عدم الحياء، تفوّقتْ على شراسة غرفة التحقيق ....
في هذه (الوحدة الشعرية) وكما في غيرها، يتأمل الشاعر في عناصر الأشياء، الأشياء الشائكة التي تُداهم الوعي وتُحاول تقويضهُ من دون أحقيّة السؤال: لماذا؟
3
إنَّ للشاعر تجربة في مقاومة التعارضات، والتجربة في (قسيب وقلالي) من 1 إلى 77 ومن 77 إلى الصفر، تبرهن على أنَّ الدورة الوجوديّة هيَ ذاتها في البدءِ والانتهاء، وأنّ هذه التجربة قادرة على احتمال الغموض وتفسيره، كما في غموض التسميتيَن: قسيب وقلالي ....:
يا مرآتي.. اسمعني
الوجود نوعان: حياة بالغفلة، وموت بالغفلة.. ولا تثق بمن
يتفلسف برأسك ويدّعي هنالك منزلة بين غفلتين.
هل يوجد أوضح من هذه الصيّحة ...؟ وكم كان الشاعر مدركاً للغفلتيَن وما بينهما ...؟
لقد كانت الوحدات الشعريّة بنثرها وشعرها وسردها إجابةً عن سريّة وعلانيّة ما حصل ويحصل في هذا الوجود المزاحَم بالتعارضات:
- أيَّ حياةٍ هذي ...؟ أيَّ حياة ...!
- أعمارنا أقلامُ رصاص: حركتنا مشروطةٌ بالمبراة
- يا مؤنسي: مررتُ بليلِ الحياة، فأوصلني لفجرِ المشنقة.
...........،
ألا يصحُّ القول إذن، أنَّ شعرية / مقداد مسعود / في (قسيب وقلالي) ذاهبةٌ إلى المعنى ...؟ ...
* جريدة الصباح 3 / 11 / 2025