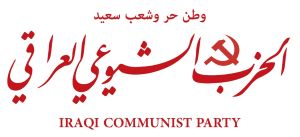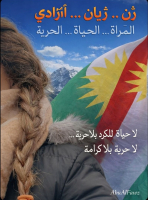طريق الشعب/ لندن
حضر جمهور متنوع في أمسية المقهى الثقافي العراقي في لندن للإستماع لإثنين من اسرة المقهى هما السينمائي والمسرحي الفنان علي رفيق والتشكيلي فيصل لعيبي صاحي، وقد خصصا الأمسية للحديث عن السينما والمسرح وفنون التشكيل العراقية .
إفتتح الأمسية الفنان علي رفيق بكلمة ترحيبية ومنبها الى ان برلمان جمهورية العراق الحالي ألغى عيد يوم الجمهورية مع انه يشّرع تحت سمائها القوانين مع تجاهل الحكومة العراقية كذلك مع الأسف ، لكننا آلينا على انفسنا ان نقيم امسية حول الثورة المغدورة وعلاقتها بالثقافة العراقية الوطنية، مع العلم بان المقهى قبل عشرة سنوات قد أقام امسية حول الثورة والثقافة كذلك ، شاركت فيها شخصيات ثقافية مرموقة مثل الفنانة ناهدة الرماح وعميد الصحافة الوطنية فائق بطي والمعمار والمفكر رفعة الجادرجي و الشاعر والمترجم صلاح نيازي قدموا فيها عرضا شاملاً عن مختلف جوانب الإبداع الثقافي ، لهذا فالأمسية هذه الليلة ستخصص أيضاً للثقافة وتطورها خلال النصف الأول من القرن العشرين حتى قيام الثورة ومدى تأثير مبدعيها على الوعي العام التي صاحب تحولاتها عبر العقود المختلفة، وقد بدأ حديثه عن السينما بشكل مكثف، إذ ذكرأن اول عرض سينمائي في العراق قد أُقيم عام 1909،أي بعد إكتشاف السينما من ، قبل الأخوين لوميير عام 1892 أي بعد 17 عاماً فقط ، وكانت العروض عبارة عن اخبار وثائقية عن العالم وما يجري خلال تلك الفترة من قبل مكاتب الدعاية والنشر الرسمية وبعض القنصليات الغربية ، ويقال أن موقع السينما في مكان يدعى البستان في منطقة العبخانة وهناك رواية تقول في دار الشفاء في الكرخ وكان احد تجار بغداد يدعى كروبي ، قد جلب مكائن متنوعة من ضمنها جهاز عرض سينمائي . وتطورت العروض فتم بناء سينمات مخصصة للعرض مثل سينما أولمبيا وسنترال سينما والوطني والعراقي وكانت الأفلام التي تم أنتاجها خلال الأربعينات ، خاصة بعد الحرب ، لآن التاجر العراقي حافط القاضي كان قد ذهب لأوربا عام 1938، لشراء اجهزة لهذا الغرض ، لكن قيام الحرب حال دون إنتاج أي فيلم، ومن افلام ما بعد الحرب كان فيلم ( إبن الشرق ) وهو إنتاج عراقي – مصري مشترك ، مثل فيه من العراقيين عادل عبد الوهاب وحضيري أبو عزيز وعزيز علي اما من الجانب المصري فكان بشارة واكيم ومديحة يسري وهو من أخراج نيازي مصطفى وكان هذا في عام 1946 والفيلم الثاني هو( القاهرة – بغداد ) ثم فيلم ( ليلى في العراق ) الذي مثل فيه من العراق أبراهيم جلال وعبد الله العزاوي وعفيفة إسكندر وجعفر السعدي إضافة الى المطرب اللبناني محمد سلمان والمطربة اللبنانية نورهان . لكن الفيلم العراقي الذي قام على اكتاف العراقيين وحدهم فيما عدا الإخراج الذي كان فرنسياً هو فيلم ( عليا وعصام )، الذي مثل فيه أيضا إبراهيم جلال والمطربتان عزيمة توفيق وسليمة مراد وكذلك عبد الله العزاوي ويحيى فايق وغيرهم. وتم تصويره في ستوديو بغداد، الذي إغلق بعد ان هاجر أصحابه الى إسرائيل كما يقال.
وفي الخمسينات ظهرت أفلام من إنتاج ياس علي الناصر وهو مخرج وممثل كذلك وحيدر العمرومحمد حسين آل ياسين أيضاً وهذه الأفلام هي : فتنة وحسن ، دكتور حسن ، أرحموني ، عروس الفرات وفيلم قصير أدبته الحياة وهو الآخر بمستوى ضعيف لم تنل النجاح المتوقع لها من قبل منتجيها، لكن هناك فيلم ( وردة ) الذي تميز بحس درامي اخرجه يحيى فايق وقتها وكان أقتباسا من يوميات نائب في الآرياف لتوفيق الحكيم . لكن عام 1956 شهد ظهور فيلم أكثر نضجا هو فيلم ( من المسؤول ) لعبد الجبار ولي . والذي مثلت فيه لآول مرة الفنانة ناهدة الرماح وسامي عبد الحميد وخليل شوقي ، عالج موضوعة الشرف والعذرية عند المرأة والتقاليد والأعراف الإجتماعية السائدة، التي أراد إدانتها من خلال هذه القصة. لكن النقلة الحقيقة في السينما العراقية سنجدها في فيلم ( سعيد أفندي ) عام 1957 وهوعن قصة قصيرة جداً للقاص العراقي ادمون صبري بإسم " شجار " لكن يوسف العاني حولها من خلال الحوار والسيناريو اللذان كتبهما الى فيلم يعالج مشاكل عديدة اهمها موضوعة أزمة السكن ،وبعض المشاهد التي تنتقد الوضع السياسي والحكومة العراقية آنذاك وقد أشار الى مشهد شراء السمكة ورأسها المتعفن وإستخدام آلة القانون الموسيقية بطريقة ساخرة لإنتقاد القضاء العراقي المتحيزاحيانا الى جانب السلطة . وهو من أخراج كاميران حسني بعد عودته من الدراسة في أمريكا ، وكان على رأس الممثلين يوسف العاني نفسه وفخرية عبد الكريم ( زينب ) إضافة الى جعفر السعدي . وقد عرض الفيلم مؤخراً في مهرجان كان الأخير كنموذج للسينما العراقية وبالتعاون في ترميمه مع المركز الثقافي الفرنسي وسفارة فرنسا في بغداد.
هذه المجموعة من الأفلام قد تم أنتاجها قبل ثورة 14 تموز ، اما بعد الثورة ، فقد تشكلت وزارة الثقافة الإرشاد ، التي إستوزرها د. فيصل السامر، الذي عمل على إنشاء مصلحة السينما والمسرح ، إذ ان النشاط الإخباري قبل الثورة كان بيد شركة نفط العراق ومكتب الإستعلامات الأمريكي التابع للنقطة الرابعة. وقد كان من اهداف مصلحة السينما والمسرح بعد الثورة تقديم نشرات أخبارية مصورة لمنجزات الثورة والمشاريع المزمع القيام بها إضافة الى بعض النشاطات الرسمية مثل زيارات المسؤولين لهذا الموقع او ذاك. اما الأفلام السينمائية التي ظهرت فهي أفلام تمجد بشكل عام الثورة وترفع شعاراتها وهي اقرب للدعاية منها لأفلام درامية تعالج مسألة جدية ، اما القطاع الخاص فأقدم على إنتاج عدة أفلام منها: فيلم ( انا العراق ) الذي مثلت وغنت فيه المطربة مائدة نزهت وسعدي يونس وهو من اخراج محمد منير آل ياسين وكذلك فيلم ( حوبة المظلوم ) اخرجه صفاء محمد علي عام 1961 وكذلك فيلم (من أجل الوطن ) لفوزي الجنابي ، ويمكن إعتبار فيلم ( قطار الساعة السابعة ) من اخراج حكمت لبيب الذي مثل دور البطولة فيه الفنان سعدي يونس بحري من الأفلام الاكثر جدية نسبياً،إذ يتناول بعض المشاكل داخل مجتمعنا العراقي الناهض وقتها، وهناك فيلم آخر هو ( اوراق الخريف ) لنفس المخرج وهو من بطولة الفنان سليم البصري وسعدون العبيدي وفيلم ( نبوخذ نصر ) وهو اول فيلم عراقي ملون مثله الفنان سامي عبد الحميد واخرجه كامل العزاوي .
أما المسرح العراقي فقد تناول المحاضر الفنان علي رفيق جانبا من تاريخه الممتد الى القرن التاسع عشر بعد ان تحدث عن إبن دانيال الموصلّي ، صاحب مسرح ( خيال الظل ) ، الذي عاش آخر أيام الدولة العباسية ومن ثم سفره الى مصر عند إحتلال المغول لبغداد، ونقله لهذا النوع من الفن إليها ومن ثم تطور الى مسرح الدمى ( قره قوز ). وهو مسرح ساخر وفيه قصص وعبر ونقد إجتماعي وقد ظهر كذلك مسرح الحكواتي ( القصه خون ) وإستمر حتى نهايات الستينات من القرن الماضي فالمسرح العربي عموماً والعراقي خصوصاُ لم يعرف إلا بعد دخول تقاليد المسرح الأوربي، أي (مسرح العلبةـ الذي يقسم معمار بنايته الى منصة "خشبة المسرح" وصالة للمتفرجين )أي المسرح المغلق بينهما جدارأ رابعا للمنصة "وهميا" يفصل بين الممثلين والنظارة. وقد عرف مثل هذا المسرح في العراق من خلال الكنائس المسيحية التي كانت ترسل بعثات الى الفاتيكان للدراسة والتعلم من اجل عكس القص الديني والكهنوتي من خلال المسرح الديني وقد عرفت مدينة الموصل قبل بغداد، هذا المسرح وتم عرض معظم المسرحيات في المدرسة الإكريليكية لكنائس الآباء الدومونيكان في الموصل إبتداء من 1750 - 1800 وقد كتب القس حنا حبش ثلاثية : ( كوميديا آدم ) و( كوميديا يوسف الحسن ) و( كوميديا طوبيا ) وقد طبعت في بيروت عام 1880، لكن في عام 1893 قام القس نعوم فتح الله السحار بتأليف مسرحية عنوانها ( لطيف وخوشابا ) التي خرج فيها عن الحس الديني إذ طرح موضوعا إجتماعيا ونقل العرض الى الأماكن العامة بحيث شاهدها عامة الناس ، وتعتبر اول مسرحية عراقية مضمونها ينطوي على معاناة الفقراء والكادحين ، أي ذات بعد طبقي واضح. اما في بغداد فقد تأثر القساوسة بما جرى في الموصل . فقدمت في التاسع من نيسان عام 1908 مسرحية ( شهيد الدستور ) المقصود به الوالي مدحت باشا ذو التوجهات الإصلاحية المعروف ، وهي تحكي مظلومية هذا الوالي وقد عرضت في مدرسة السريان الكاثوليك وقد نشر وقتها إعلانا عنها في ( صحيفة الرقيب ) البغدادية. أما الظهور الحقيقي للمسرح العراقي فقد كان بعد ثورة العشرين حيث كانت الوفود المؤيدة للثورة يقيمون نشاطاتهم وإجتماعاتهم في ( جامع الحيدر خانه ) الشهير في قلب بغداد وكان ضمن هذه الجموع الشاعر محمد مهدي البصير، الذي اطلق عليه وقتها وصف " شاعر الثورة " قد كتب مسرحية ( وفود النعمان الى كسرى انو شيروان ) والتي يكشف من خلالها مطالبة العرب بالحرية من هيمنة الفرس، موحيا بنوع من التورية الى نقد البريطانيين الذين إدعو بأنهم جاءوا محررين لا فاتحين كما ردد ذلك الجنرال مود عند دخوله بغداد . وقد عرضت عام 1923. و تلا ذلك عرض مسرحية ( فتح عموريا ) مجددا في الموصل والذي كتبها عبد المجيد شوقي البكري وأعاد ( نادي الإنتباه العربي ) ، مسرحية ( شهداء الوطنية الهولنديين )، وقد كررت اكثر من مكان وقد قدمها المربي الموصلي يحيى قاف، الذي اسس ( دار التمثيل العربي )، وكان يزرع الحس الوطني في عقول طلابه. وإستمرتقديم المسرحيات التي تتكلم عن الأحداث التاريخية العربي ، مثل ( فتح مصر عام 1924)، ( فتح القادسية عام 1934 ) و ( فتح الشام عام 1936).
في بغداد تم تأسيس ( الفرقة العربية للتمثيل ) من قبل المسرحي خالص الملا حمادي ، الذي وضع لها برنامجا واهداف تتجلى في الكفاح السلمي ضد قوى الإحتلال والإستعمار وفي الثلاثينات أيضاّ قدمت مدرسة للبنات مسرحية ( الفتاة العراقية ) من تأليف محمود النديم وهي تنتصر لحقوق المرأة وحريتها ، وعلينا ان نذكر الفرق المصرية التي زارت بغداد مثل فرقة جورج أبيض وفرقة عزيز عيد وفرقة فاطمة رشدي وفرقة رمسيس التي كان من أبرز روادها عميد المسرح المصري يوسف وهبي ، وذكر حادثة كومبارس (مسرحية شريف روما ) التي عرضت في مقهى البلدية في منطقة الميدان، لأن الفرقة لم تكن تملك كومبارس يكفي ليمثل أشراف روما وقتها فتم الإستعانة بجمهور المنطقة الذين يعمل معظمهم في بيوت الدعارة هناك ، مما جعل العرض ساخرا وساده الهرج والمرج لأن الجمهور يعرف معظم الذين إرتدوا ملابس أشراف روما من سكان المحلة المشهورة. وتعتبرهذه الفرق الزائرة رافداً مهماً في تعريف الجمهور العراقي بطبيعة المسرح الفني وشروطه وكذلك المواضيع التي يطرحها وأعطته صورة جيدة عن اهمية المسرح في حياة المجتمع ، وكان من بين من تأثر بهذا النشاط عميد المسرح العراقي حقي الشبلي الذي ألف الفرقة الوطنية للتمثيل عام 1927، التي بدأت عروضها بمسرحية ( جزاء الشهامة ) و ( صلاح الدين الأيوبي ) و( وحيدة ) و( في سبيل التاج ) . لقد كانت مسرحية ( وحيدة ) مسرحية تحريضية، كتبها احد موظفي السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية ، يدعى موسى الشابندر وهي تصف العوائق التي تواجه العشاق من جهة والإحتلال من جهة اخرى أي ضد التقاليد التي تقف في وجه المحبين وضد القوى الخارجية التي تهيمن على البلاد ، كما كتب عنها الفنان سامي عبد الحميد. وكان نشاط هذه الفرقة وخاصة في مسرحية ( شهداء الوطنية ) قد دفع رئيس الوزراء محسن السعدون الى إرسال الفنان حقي الشبلي الى القاهرة للإطلاع على المسرح المصري المزدهر آنذاك. وقد أعاد إنتاج هذه المسرحية الفنان حقي الشبلي في ستينيات القرن الماضي مجدداً. وقد أُعتبرت فترة الثلاثينات أفضل فترة بالنسبة للمسرح العراقي بإعتراف مؤرخيه والمهتمين به.
توقف النشاط المسرحي منذ بداية الحرب العالمية الثانية ، لكن عند عودة حقي الشبلي عام 1939 من فرنسا تم تأسيس قسم المسرح في معهد الفنون الجميلة الى جانب إفتتاح قسم الرسم الذي ترأسه الفنان الكبير فائق حسن .
ولم يتم إنتاج اعمال مهمة، إلا بعد تخرج الدورة الأولى للمسرح من معهد الفنون الجميلة ، مثل، إبراهيم جلال، سامي عبد الحميد، جعفر السعدي، ناظم الغزالي ورضا علي وقسم من جماعة ( فرقة الزبانية ). وهي المجموعة التي إعتمدت على أصول الفن المسرحي الكلاسيكي أو الأكاديمي، بناءً على ما تعلمه الأستاذ حقي الشبلي في (لا كوميدي فرانسيز ). وهو مسرح يعتمد على جسد الممثل وصوته وحركاته والعبارات اللغوية الفخمة وليس على الجانب النفسي والذاتي أو الداخلي للممثل. وقد تأسست في النصف الثاني من العقد الخامس من النصف الأول من القرن العشرين ( الفرقة الشعبية للتمثيل ) من قبل إبراهيم جلال وجعفر السعدي، وقدموا مرة اخرى مسرحية ( شهداء الوطنية )، وتزامن عرضها مع فترة إعدام قادة الحزب الشيوعي الأربعة : فهد ، صارم، حازم ويهودا صدّيق. وقد تعرضت الفرقة للتحقيق والمساءلة من قبل الشعبة الخاصة من التحقيقات الجنائية، وقتها .
عام 1952 أعادت الفرقة نشاطها بمسرحية ( الفلوس ) وهي من تأليف الكاتب التركي نجيب فاضل، وبعد عام قدمت مسرحية من الأدب العالمي بإسم ( القبلة القاتلة ) ومسرحية ( هناك ) وهي من تأليف الكاتب الأمريكي وليام سارويان ، وفي عام 1956 قدمت مسرحية ( المورد المسموم ) وهي معدة عن مسرحية المؤلف المسرحي الشهير هنريك إبسن( عدو الشعب). وفي العام ١٩٥٢ تم تأسيس ( فرقة المسرح الحديث ) التي إستمر نشاطها حتى عام 1957 ، حيث أغلقتها الدولة بعد ان نفذ صبر النظام الملكي جراء تقديمها العديد من نصوص الفنان يوسف العاني الإنتقادية الساخرة مثل ( ماكو شغل ) و . وهذا ما إضطر يوسف العاني الى السفر خارج العراق وظل هناك حتى قيام ثورة 14 تموز عام 1958. ). واما الفرق المسرحية الأخرى مثل الشعبية قدمت مسرحية ( ماكو شغل ) للعاني و( عودة الولد المهذب ) لشهاب القصب. وسبق ذلك ان تشكلت في كلية الحقوق مجموعة تمثيل بإسم ( جبر الخواطر) شكلها طلبة الحقوق هواة المسرح مثل يوسف العاني وسامي عبد الحميد وأسعد عبد الرزاق . والجدير بالذكر وبسبب من عدم إستيعاب القاعات للنشاط المسرحي ، قامت فرقة المسرح الحديث ببناء مسرح على شاطيء دجلة في الأعظمية وهو بناء بسيط يشبه (جراديغ) المستحمين على نهر دجلة خلال فترة الصيف، وهناك جرى عرض مسرحيات يوسف العاني مثل ( تؤمر بيك، ماكو شعل، لو ظلمة لو سراجين ) وغيرها.
وكما ذكرنا حول وزارة الثقافة والإرشاد التي كان على رأسها الدكتور فيصل السامر فقد خططت هذه الوزارة لإقامة مهرجان مسرحي ، فأقيم اول مهرجان في عام 1962على قاعة الشعب، التي هي قاعة الملك فيصل الثاني قرب وزارة الدفاع ، وقد شاركت ثلاث فرق مسرحية في هذا المهرجان الذي يبدوعليه الإرتجال نوعاً ما ، فقدمت ( فرقة المسرح الحديث ) مسرحية ( الخال فانيا ) لتشيخوف، وقد اخرجها عبد الواحد طه . ومثلها أعضاء الفرقة ، مثل الفنانة زينب وسامي عبد الحميد وغيرهما. وكانت مسرحية جادة، صعبة التنفيذ، مثل بقية أعمال تشيخوف الأخرى و (فرقة المسرح الشعبي ) قدمت مسرحية ( بيت الدمية ) لأبسن ، فكانت مناسبة جداً مع ما كان يجري على الأرض، من اجل حقوق المرأة العراقية وموضوع قانون الأحوال الشخصية الذي سنته للتو حكومة الثورة بدفع من القوى السياسية التقدمية والحركة النسوية النشطة، والذي تم شطبه من قبل برلمان المحاصصة والفساد الحالي. اما المسرحية الثالثة كانت من إنتاج ( فرقة المسرح الجمهوري ) وهي مسرحية ( سقط المتاع )، من إخراج الفنان يحيى فايق والتي تعالج مرض الزهري تنطوي على انتقاد المجتمع الفاسد بشكل رمزي .
الى جانب الموسم المسرحي للوزارة قام معهد الفنون الجميلة ايضا بتقديم موسمه الخاص به تزامنا مع خطة الوزارة في إنعاش الحياة الفنية وقتذاك. فقام أساتذة المعهد في إخراج هذه الأعمال ولموسمين متتاليين ، الأول والثاني وقد ساهم المحاضر في هذه المواسم . كان الأستاذ بهنام ميخائيل قد اخرج مسرحية ( أفول القمر ) للأمريكي جون شتاينبك، والأستاذ جاسم العبودي أخرج مسرحية ( عطيل ) لشيكسبير وهو بالمناسبة عندما عاد عام 1955 الى بغداد بعد دراسته في أمريكا ، قد ادخل طريقة المخرج الروسي الشهير( كونستانتين ستانسلافسكي ) المعروفة بـ " الطريقة" التي دونها نظريا بكتابه ( فن إعداد الممثل )، واختار الأستاذ جعفر السعدي مسرحية ( أوديب ملكاً ) لسوفوكلس ، بينما اخرج الأستاذ جعفر علي مسرحية ( البرجوازي النبيل ) لموليير فقدمها تحت إسم ( المثري النبيل ) معمقا السخرية من طبقة الطفيليين محدثي النعمة.
من الضروري التذكير، بأن الحركة المسرحية قد إرتبطت من البداية بالحركة الوطنية وبقلة النصوص العراقية ولهذا إعتمدت على النصوص العالمية وتكرارها ولم يكن هناك فرقة رسمية ترعاها الدولة، وقد اشار المحاضر الى حضور سكرتير الحزب الشيوعي العراقي ( فهد ) سراً لمشاهدة هذه العروض كما يذكر الفنان يحي فايق وكذلك كان سكرتير الحزب سلام عادل في قناعته بدور المسرح الكبير في توعية الجماهير، إذ اخرج مسرحية ( في سبيل التاج ) في الديوانية كما يذكر الفنان سامي عبد الحميد، حيث إختاره استاذه سلام عادل في الثانوية ليلعب دور بطولة المسرحية ، وكذا الحال مع محمد صالح العبلي الذي أخرج ومثل في مسرحية ( قيس وليلى ) في الإعدادية المركزية في بغداد ولكن باللهجة اليهودية البغدادية كما يذكر الأستاذ حمدي التكمه جي. وعلينا أن لا ننسى مسرح السجون والتي كانت تقام في نقرة السلمان والكوت وغيرها من المعتقلات، رغم بساطة العروض والإمكانيات .
واخيراً فإن الثورة قد قامت في وضع الحجر الأساس للأوبرا وتوسيع دائرة المسرح فأصبح في كل بناية مدرسة حديثة البناء ، قاعة ومسرح وكذلك إجازت الثورة الفرق المسرحية ودعما احيانا وخففت عنها ضريبة الملاهي التي كانت تأخذ 75 % من عوائد شباك التذاكر في كل مسرحية ، لأن الدولة تطبق قانون الملاهي على المسرح آنذاك.
لقد قامت الثورة أيضاً بإفتتاح أكاديمية الفنون الجميلة وكان عميدها الأول الفنان والأستاذ د. خالد الجادر 1964. عرضت خلال أيام الثورة مسرحيات عديدة ، لكن من أهمها كانت مسرحية ( آني أمك ياشاكر ) قدمتها فرقة المسرح الحديث على قاعة الشعب في الشهور الأولى للثورة وحضرها الزعيم عبد الكريم قاسم ، وهي تحكي ما تعرض له السجناء أيام العهد الملكي من قمع وإرهاب وقد فقد شعبنا وقتها أكثر من ثمانية شهداء جراء ذلك. ومسرحية ( فجر الثورة ) التي قدمها يحيى فايق وقد إستمرت هذه العروض لفترات طويلة، لم تعهدها سابقا الحركة المسرحية وانتقلت عروضها ايضا الى عدة مدن .
ثم تحدث الفنان التشكيلي فيصل لعيبي صاحي عن المقدمات التي تمتد الى ظهور الإسلام الذي، أتهم بمعاداة الفن وأكد ان هذا غير صحيح ، لأن في القران هناك آيات تشجع على الإبداع والفن وخاصة النحت مثل الآيتين ال ( 11 – 12 ) والتي تقول : " 11.ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ( النحاس – الكاتب ) زمن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، 12. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ، إعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور "
وكذلك عند فتح مكة وجد المسلمون رسوما في جوف الكعبة فارادوا مسحها، لكن النبي وضع يده على رسم مريم وعيسى وقال لهم : "أمسحوا إلا ما تحت يدي " وهناك أيضا وصف لله كونه المصور وهو الذي يصور عباده في الأرحام وأيضاً يصف نفسه بأحسن الخالقين ، وهذا يعني ان هناك خالقين غيره ولكنهم لا يصلون الى مستوى خلقه. وخلال الفترة الراشدية لم نلحظ ما يشير الى تحريم الرسم وقد جاء هذا بعد ذلك من قبل بعض الفقهاء مثل إبن عباس وغيره. وقد ظلت رسوم إيوان كسرى شاخصة حتى العصر العباسي وقد تحدث عنها البحتري في قصيدة مشهورة ونحن نعرف ان العصر الأموي قد شاعت فيه الرسوم الجدارية والموزاييك وحتى رسوم النساء العاريات .وإذا جئنا الى العصر العثماني فقد جلب السلطان محمد الفاتح الفنان بلليني كي يقوم برسمه والصورة موجودة في متحف الأوفتسي في فلورنسا أما في المنطقة العربية فقد ذكر لنا المؤرخون ان اول من إهتم بالفن والرسم والتماثيل هو الأمير فخر الدين من جبل عامل ( 1572 – 1635 ) وأيضا الأمير بشير الثاني ( 1767 -1850 ) وفي الشمال الأفريقي كان خليفة قسطنطينة علي بن احمد قد دعا الفنان الفرنسي تيودور ساشيرو عام 1846 ليرسمه على فرسه وكذلك فعل محمد علي باشا ( 1769 – 1849 ) في مصر حيث كثرت سفرات الفنانين والمعماريين الأوربيين لمصر في أيامه وايام من خلفوه فإمتلات القاهرة بالمباني على الطراز الأوربي وزينت الساحات والقصور بالرسوم والتماثيل وتوسعت الشوارع وبنيت القناطر والجسور على الطرز الغربية .
اما في العراق فيمكننا، كما يقول المحاضر فيصل ان نؤرخ لظهور الرسم والرسامين من خلال الفنان البغدادي ( نيازي مولوي بغدادي ) ،إ بتداءً من عام 1864، ورسومه ليست بعيدة عما هو سائد في الرسم التركي والفارسي آنذاك . يأتي بعد مجموعة الضباط العراقيين الذين كانوا يعملون في الجيش العثماني ولكن بعد نهاية السلطنة عادوا الى العراق وهم كل من : عبد القادر رسام ، عاصم حافظ، محمد صالح زكي والحاج سليم علي والد جواد سليم . ورسوم هؤلاء عموما تقع ضمن الأسلوب الغربي السائد في القرن التاسع عشر ، مثل الصور الشخصية والمناظر والحياة الجامدة ولقد برز عبد القادر رسام كأهم فنان من بينهم .
قد تكون لوحته المسماة بـ ( طائرة فوق ملوية سامراء –مرسومة في 1936 )، اول لوحة من وجهة نظري للتعبيرعن رفضه للإحتلال كما يقول المحاضر وتدل عن الهيمنة الأجنبية على العراق ، فالطائرة بريطانيا والملوية هي رمز مدينة سامراء التي بناها المعتصم لجنوده الأتراك ولما كان الإنقطاع عن الجو العثماني بالنسبة لضابط عراقي مسلم أُجْبِرَ على ترك مهنته العسكرية بسبب الحرب ونهاية السلطنة التي تربى في احضانها ، فأني اظن انه حاول التعبير عن رفضه للإحتلال البريطاني بهذه الطريقة وقد أكون على خطأ وقد عرض المحاضر مجموعة من أعمال هذه النخبة من الفنانين الذين شكلوا الريادة في الرسم إبتداءً من عشرينات القرن الماضي . بعدها ونظراً لضيق الوقت حاول المحاضر ان يعطي بعض الملاحظات عن خمسة فنانين لعبوا دوراً مفصلياً في التشكيل العراقي المعاصر، هم : جواد سليم، فائق حسن، محمود صبري، شاكر حسن آل سعيد وجميل حمودي .
فهو يعتبر جواد سليم أول فنان إنتبه الى موضوعة المحلية والمعاصرة وقدم منذ عام 1944 ، بعض الأعمال التي تعبر عن هذا الهم وخاصة في رسوماته مثل الإبن المقتول ومنحوتة البناء ( الأسطة طه ) عام 1944، كتعبير لإنشغاله في موضوع علاقة الفن بالمجتمع ، وقد جمعتهم مرة مع الفنان البولوني جابسكي جلسة في المقهى البرازيلية في بغداد عام 1942، تبادلوا فيها هذا الموضوع حيث أكد جابسكي على ضرورة ان يرتبط عمل الفنان بما يجري في مجتمعه وكان ( نصب الثورة ) الذي أنجزه جواد في بداية ستينات القرن الماضي، من أهم الأعمال التي تمثل ثورة 14 تموز المجيدة ، حيث مثل فيها كل فئات المجتمع وتاريخ نضالها حتى يوم النصر وكذلك الأهداف المرجوة منها ، إذ يعتبر أكبر نصب فني إنجز في منطقة الشرق العربي منذ نهاية الدولة الأشورية في منتصف القرن السابع قبل الميلاد . وكانت الفكرة الأولية له من بنات افكار المعمار الشهير الأستاذ رفعة الجادرجي ، الذي قال لجواد لنصنع لافتة فنية تشبه لافتات الجماهير التي تجول شوارع بغداد وقتها .
وقال المحاضر ، كان الأستاذ رفعة يرى ان الفنان محمود صبري قد لعب دوراً محورياً في توجيه حركة الفن التشكيلي العراقي المعاصر نحو القضايا الإجتماعية والسياسية وكان الأستاذ رفعة يعتقد أيضا بضرورة ان يرتبط الفن بقضايا المجتمع، لكنه لا يؤيد الفنان محمود في تحديد اللوحة بتوجه سياسي معين.
اما الشخص المهم الثاني في الفن التشكيلي فهو الفنان الكبير فائق حسن الذي كان المبادر والرائد في تغيير تقينة اللوحة العراقية والإنتقال بها من الإسلوب الأكاديمي والرومانتيكي، الذي أتصفت به عند الفنان عبد القادر رسام ومجايليه، الى المغامرة في التقنيات والملمس والسطح وحركة الفرشاة وكثافة اللون وهو أيضا اول من قدم لوحة مختلفة حتى عما كان يمارسه من أسلوب عرف به وهي لوحة
( الفلاحة والمعزة ). كان جواد وفائق في فترة التعاون المشترك بينهما كما يقول المحاضر، قد خلقا ثنائيا رائعاً دفع بالرسم العراقي الى المعاصرة والحداثة والمحلية في آن واحد. ويأتي الفنان محمود صبري ليكمل الزاوية الثالثة في اللوحة العراقية ، بتقديمه الموضوع السياسي والإجتماعي الذي كان غير واضح آنذاك في أعمال الفنانين بمثل هذا الوضوح. اما الفنان شاكر حسن فقد قدم أعمالاً مهمة ضمن توجه (جماعة بغداد للفن الحديث) تعكس نضجه وريادته كذلك وهو من المفكرين ومساهم فعال في النقد الفني والتنظير الجمالي الى جانب الفنان محمود صبري والمعمار رفعة الجادرجي وان أعمالهم النظرية يجب ان تدرس في المعاهد والكليات الفنية العراقية وحتى العربية لأهميتها وجديتها وتميزها بالمعاصرة والتجديد.
بقي عندنا الفنان الخامس وهو الفنان الرائد جميل حمودي الذي لم يُدرس جيداً وأهمل نسبياً من قبل كتاب المقالات الفنية والنقاد كما يقول المحاضر، فهو يعتبره أكثر طليعية في بعض أعماله من الفنانين الأربعة الذين مرَّ ذكرهم ، إذ انه اول من تناول فن التجريد وبهذه القوة والمتانة والوعي وكذلك في إستخدامه للحرف العربي وتطويعه في أعماله المبكرة وحتى في الأعمال النحتية التي انتجها، ويظن المحاضر أنه في حاجة الى قراءة جديدة ومن زاوية مختلفة لما كان سائداً من مفاهيم عند ذاك.
بعدها فتح باب النقاش وتحدث المهندس الأستاذ كريم السبع حول موضوعة التشابيه الحسينية وهل يمكن إعتبارها شكلاً من اشكال المسرح أم لا؟ وكذلك طالب الدكتور عدنان رجيب من المحاضرين بتوضيح تاُثير الثورة على الثقافة والثقافة على الفن اكثر مما طرح ، اجاب عليها المحاضران بشرح مسهب لما كان يقصدان بذلك وقدما نماذج إضافية للتوضيح.
 |
 |
 |
 |