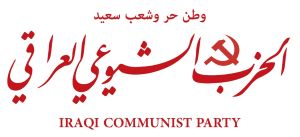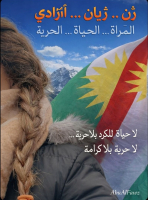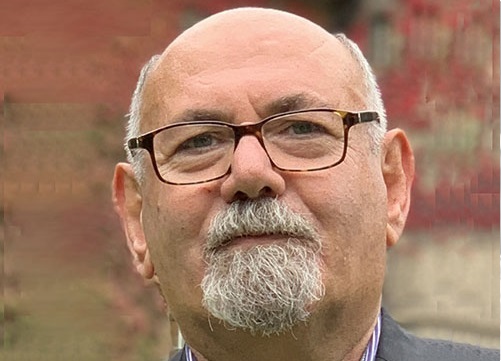
في دراسة نشرتها مجلة نيو لفت ريفيو (اليسار الجديد) بعدديها 153 و154 لسنة 2025، أكد الباحث آرون بيناناف* أن الاضطرابات السياسية الراهنة تُخفي وراءها خللاً اقتصاديًّا عميقًا، يعكس أزمة الرأسمالية، حيث تتباطأ معدلات النمو في الدول المتقدمة، وتتركز السلطة الاقتصادية في أيدي عددٍ قليلٍ من الشركات الكبرى التي تنهب المكاسب المتأتية من تحفيز الاقتصاد، وتحتكر سلاسل الإنتاج العالمية، وتحتفظ بحقوق الملكية، تاركةً عمليات الإنتاج لجهاتٍ خارجيةٍ أرخصَ سعرًا وأشدَّ قدرةً على التنافس فيما بينها، مع تحويل معظم الأرباح التي تُحقّقها إلى أصول مالية مؤمَّنة بعمليات الإنقاذ الحكومية.
وقد باتت هذه الشرائح الصغيرة تتحكَّم بقرارات الاستثمار التي يتوقف عليها مستقبل الحياة على الأرض، كالهندسة الجيولوجية، والذكاء الاصطناعي، واحتجاز الكربون، والطاقة النووية، في وقتٍ يجري فيه تحوُّلٌ أفقيٌّ من التصنيع إلى الخدمات، كالصحة والتعليم والإدارة، وهي نشاطاتٌ تتسم إنتاجيتها بمعدلات نموٍّ متدنية، ولا يتحقق فيها الربح إلا من خلال تكثيف الاستغلال أو رفع الأسعار.
الرأسمالية ومشكلة الربح
رغم أن الرأسمالية تعني تاريخيًّا نوعًا مميزًا من اقتصاديات السوق، قائمًا على تركيز الملكية الخاصة واستغلال العمال ونهب الموارد لإثراء المستثمرين، فإنها ساهمت، بمجرى تنافسها على الربح، في خدمة غاياتٍ مفيدةٍ اجتماعيًّا، كالكفاءة الاقتصادية والديناميكية، وكإحداث قفزاتٍ هائلةٍ في مستويات المعيشة المادية ونشر الابتكارات.
لكن نجاحات الرأسمالية هذه هي ما سبَّب أزماتها؛ فالتوسع الهائل في التصنيع أدَّى إلى تخريبٍ أكبرَ للبيئة وتهديد الحياة على الكوكب. كما أصاب تراجع الكفاءة الاقتصادَ بالركود، وشجَّع على هروب رؤوس الأموال إلى الأصول المالية، وزيادة التفاوت، وتدنّي الأجور، وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية، وتفاقم مشاكل الفقر والمرض وعدم كفاية المساكن والاغتراب الاجتماعي والضغط النفسي، وترسيخ سلطة الاحتكار التي اشتدَّت عدوانيةً، فراحت تُقلِّص مكتسبات الشغيلة، وتتمسك بأولوية الربح على كل القضايا والمبادئ، كالاستهلاك الأخلاقي، والتدابير الاجتماعية الديمقراطية، والتنظيم البيئي، والحوكمة، وغيرها.
ويعود البحث عن معيارٍ اقتصاديٍّ غير الربح إلى بدايات الرأسمالية نفسها. ففي رواية "يوتوبيا" لتوماس مور (1516)، يقول الراوي: "حيثما يكون المال مقياس كل شيء، يصبح من المستحيل أن تكون الدولة عادلة أو مزدهرة."
وفي القرن الثامن عشر، رأى روسو في فرنسا أن القانون لم يكن سوى مبررٍ للأغنياء، وأنه يجب تقليص دور المال بشكلٍ حادٍّ إن لم يكن إلغاؤه. وبعد جيلٍ من الطوباويين (أوين وفورييه وسان سيمون) رفع الجمهوري الراديكالي إتيان كابيه شعار"لكلٍّ حسب حاجته، ومن كلٍّ حسب قدرته"، وهو الشعار الذي استعاره ماركس لوصف "المرحلة العليا من المجتمع الشيوعي" في كتابه "نقد برنامج غوتا" (1875)، مؤكِّدًا على أن مجرَّد إدخال شكلٍ "أصدق" من النقود قائمٍ على وقت العمل لن يقضي على عدم المساواة، بل يجب تغيير نمط الإنتاج بأكمله، مع إحلال التنظيم المجتمعي محل السعي وراء الربح الخاص، ومتنبئًا بظهور قيمٍ أخرى مع التنظيم الجماعي للاقتصاد.
وكادت الموجة الثورية التي اندلعت بين عامي 1917 و1921 أن تحقق شروط ماركس المتمثلة في اقتصادٍ يُدار من قِبَل المجتمع، متحررٍ من المال والملكية الخاصة.
لكن الفرصة ضاعت، وواجهت الحركات العمالية مقاومةً شرسةً من الطبقات الحاكمة، ثم راحت تواجه هياكلَ رأسماليةً اقتصاديةً واجتماعيةً أكثرَ تعقيدًا، مدعومةً بوسائل الإعلام الجماهيري، ومسنودةً بطبقاتٍ اجتماعيةٍ وسطى.
كما وقعت تغييراتٌ بنيويةٌ أعمق؛ فلم تتقارب الأشكال التقنية للعمل مع القيم الاجتماعية، وأدَّت التنمية الصناعية إلى خلق أنماطٍ من التخصص أثَّرت سلبًا في تجانس الطبقة العاملة وآليات تنظيمها، فيما ظهرت حركاتٌ اجتماعيةٌ وقوميةٌ وبيئيةٌ جديدة، كالنسوية، والمناهضة للعنصرية وللاستعمار، راحت تطرح مطالبَ متباينةً ومتنافسةً حول ما الذي يُعتبَر مهمًّا، مثل الاستقلالية، والأمان، والكرامة، والرعاية، والاستدامة، وحول كيفية ترتيب هذه القيم وتحديد أولوياتها.
إن تجاوز أزمة الرأسمالية من جهة، وتخطِّي هذه المآزق الخطيرة والمتغيرات البنيوية من جهةٍ مكمِّلة، لا يمكن أن يتحقَّق باللهاث وراء الربح، بل يتطلَّب، حسب بيناناف، تطويرَ نظامٍ اقتصاديٍّ يتجاوز الرأسماليةَ نفسها، نظامٍ جديدٍ يقوم على تعدُّد المعايير، حيث لا يكون الربح هو الهدف الوحيد، بل تتداخل معه أهدافٌ أخرى، ويتم التوازن بينها عبر نقاشٍ سياسيٍّ ديمقراطي، فهذا النظام متعدد المعايير يستلزم إعادة تنظيمٍ عميقةٍ لعملية الإنتاج وطرائق اتخاذ القرار الاقتصادي.
الاشتراكية والتخطيط
بحلول عام 1921، ومع انتصار الجيش الأحمر في الحرب الأهلية، بدأ الاتحاد السوفيتي الوليد في بناء أول مجتمعٍ صناعيٍّ مُخطَّطٍ مركزيًّا، واستبدال توزيع السوق بخططٍ خمسيةٍ مركزيةٍ لا تهتم بالربح، بل بتعظيم الإنتاج.
وقد حققت تلك الخطط، التي طُبِّقت بين ثلاثينيات وخمسينيات القرن العشرين، صناعاتٍ متطورةً باستثماراتٍ ضخمة، مؤكدةً أن التخطيط المركزي واستخدام الاستثمار المنسَّق كمحرّكٍ للتنمية الاقتصادية يمكن أن يوفرا ديناميكيةً صناعيةً استثنائيةً، ويعجّلا نموَّ وتطويرَ البنية التحتية، ويوسّعا القدرات الإنتاجية، والتي لولاها ما كان ممكنًا للاتحاد السوفييتي أن يهزم ألمانيا النازية.
ومهما كان الموقف من الستالينية، لا يمكن إنكار إنجازاتها التنموية. فبعد دمار الحرب العالمية الثانية، استأنف الاتحاد السوفيتي نموَّه لعقدين آخرين؛ وشملت ابتكاراته القنبلة الهيدروجينية، وإرسال أول إنسانٍ إلى الفضاء، وتحقيق مستوى أساسيٍّ من الأمن الاقتصادي لسكانه، مع فرص عملٍ وفيرة، وتوظيفٍ أعلى للنساء، ورعاية أطفالٍ عامة، ودولةِ رعايةٍ اجتماعيةٍ شاملة.
لقد استهدف الاقتصاد المخطَّط تلبيةَ الحاجات الفعلية للمجتمع، مع حسابٍ دقيقٍ لكمية العمل المطلوبة لإنتاج كل سلعةٍ أو خدمة، مما يمنع الاستغلال ويساهم في تنظيم الإنتاج وتجنّب الهدر بالموارد والنقص في الكفاءة، خاصةً في حالات التغيير الكبرى مثل بناء صناعاتٍ جديدة، أو التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، أو تقليل استخدام البلاستيك. وفيما يعيش النظام الرأسمالي صراعًا حادًّا حول توزيع الدخل بين العمال وأصحاب رأس المال، ارتكز الاقتصاد المخطَّط على مبدأ العدالة الاجتماعية.
لقد عمد بعض الاشتراكيين إلى استخدام وقت العمل كوحدةٍ أساسيةٍ لحساب قيمة الأشياء؛ فإذا عرفنا كم ساعةَ عملٍ يحتاج إنتاجُ كل شيء، يمكننا توزيع العمل والموارد بدقةٍ لتلبية احتياجات المجتمع دون الحاجة إلى السوق. وبهذا الشكل، يحصل كلُّ شخصٍ على ما يناسب مساهمته أو حاجته، بشكلٍ شفافٍ وعادل.
لكن التجربة السوفيتية أظهرت أن لهذا النهج حدودًا، فاختزال كل شيء إلى ساعات عمل لا يعكس الفروق الكبيرة بين أنواع العمل والموارد المختلفة، مما استدعى تطوير طرقٍ أكثرَ عملية، مثل نماذج "المدخلات والمخرجات" التي تحسب المواد والعمل والطاقة المطلوبة لإنتاج كل شيء.
ومع ذلك، ظهرت مشاكل في التطبيق، أولها صعوبة وضع خطةٍ موحدةٍ لأن المصانع تختلف في معداتها وظروفها الجغرافية وطرق عملها، وثانيها عدم مرونة الخطط المحكمة في التعامل مع المتغيرات المفاجئة مثل تأخُّر المواد أو تغيّر الطلب، وثالثها الاهتمام بإنتاج أكبر قدرٍ ممكنٍ بأقل تكلفةٍ دون الالتفات إلى الأهداف الأخرى مثل تقليل التلوث أو تحسين بيئة العمل.
وبمجرد أن عانى الاقتصاد شديد المركزية من نقص الموارد جراء انخفاض عائدات النفط والإنتاجية، في ظل إهمال الأسعار السوقية، أصيب بالركود المزمن، واختناقات في المعلومات، وصعوبة في التكيّف مع التغيرات، ومشكلات في مرونة السوق، فراح يصنع منتجات ناقصة الجودة أو غير مناسبة، وتعطلت سلاسل الإمداد، وانتشر الهدر وظهرت السوق السوداء كآليةٍ للبقاء.
ورغم اتفاقه مع تصوّر أوغست بيبل عن توافق المصالح الشخصية مع المصالح الاجتماعية، بحيث يكون إشباع الأنانية الشخصية متناغمًا مع خدمة المجتمع، ومع ما أكده ماركس وإنجلز وكاوتسكي من أن النظام الاشتراكي سيسعى منذ البداية إلى تنظيم الإنتاج ديمقراطيًّا، يرى بيناناف أن الاشتراكية لن تستطيع تعظيم جميع الأولويات دفعةً واحدة، حتى حين تكون قادرةً على الجمع بين تأمين أوقات عملٍ وراحةٍ مناسبة وتوازنٍ بيئيٍّ ورعايةٍ اجتماعية، مما يستدعي حوارًا مجتمعيًّا حول كيفية تنظيم الإنتاج واتخاذ القرارات الاقتصادية، على طريق بناء نظامٍ اقتصاديٍّ متعدد المعايير.
إن توسيع هذا المفهوم للديمقراطية الاقتصادية يمر عبر نقد الطرائق المحدودة التي فُهمت بها هذه الديمقراطية في الماضي، والبحث في مصير فكرة الاشتراكية متعددة الأبعاد وهي تواجه التعقيد المتزايد للمجتمع الرأسمالي الحديث، وابتكار أشكالٍ من التنسيق تتجاوز دافع الربح والتخطيط المركزي إلى نموذجٍ أوسع يراعي تعدد الأهداف مثل العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وجودة الحياة، والتعليم، والفن، والمشاركة المجتمعية. ولكي يحدث هذا، يجب ألا يكون التخطيط مجرد عملٍ تقنيٍّ وحساباتٍ رقمية، بل عمليةً ديمقراطيةً يشارك فيها الناس في تحديد أولوياتهم وما يريدون تحقيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أَروِن بيناناف مؤرخ اقتصادي ومنظر اجتماعي متخصص في موضوعات العمل، والأتمتة، والتوظيف، وتغيّرات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى البدائل الممكنة للرأسمالية.