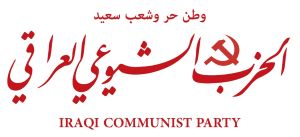الاغتراب (Alienation) هو أحد المفاهيم الأساسية التي طُرحت في الفلسفة السياسية قبل ماركس. فقد أشار فويرباخ إليه في كتابه (جوهر المسيحية) لشرح استلاب الدين وطبيعته، متأثراً بالفكر الجدلي الهيغلي. رأى فويرباخ أن الدين، بصوره المختلفة، هو أول مواجهة معرفية للإنسان مع جوهره وطبيعته الخاصة، إذ يتموضع الوعي البشري في كيان خيالي خارجي، ويُسقط الإنسان خصائصه الجوهرية العامة على هذا الكيان، مما يجعله خالقاً لما يصبح لاحقا خالقه. أي أن الإنسان، وفقا لفويرباخ، يخلق الآلهة ثم يخضع لها، وبذلك يصبح الدين انعكاساً لاستلاب الإنسان لنفسه.
أما ماركس، فقد تناول هذا المفهوم ضمن قراءته للنظام الرأسمالي، وركز على مضمونه الاقتصادي والاجتماعي، إذ رأى أن الاغتراب هو الحالة التي يفقد فيها الإنسان جوهره الاجتماعي نتيجةً للهيمنة الاقتصادية الرأسمالية، التي تسلبه ملكية عمله وعلاقته بمجتمعه.
يرى ماركس أن جذور الاغتراب تكمن في العلاقة الاستغلالية بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة، حيث تؤدي هذه العلاقة إلى تمركز وسائل الإنتاج والثروة بيد الرأسماليين، بينما يجبر العمال على بيع قوة عملهم لضمان بقائهم. هذا يؤدي إلى خلق حالة من الاستغلال الدائم، حيث يصبح العمال مجرد أدوات لزيادة رأس المال، في حين يحرمون من السيطرة على ناتج عملهم، مما يولد التناقضات والصراعات الطبقية.
في ظل هذه التناقضات، تعاني الطبقة العاملة من أزمة الاغتراب، التي تتمثل في البطالة والفقر والتفاوت الاجتماعي، حيث يجرد العمال من أي قدرة على التحكم بمصيرهم، ويتحولون إلى أدوات إنتاج ضمن منظومة لا تخدمهم، بل تكرس استغلالهم.
أشكال الاغتراب :
في المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1844، يحدد ماركس أربعة أشكال رئيسية للاغتراب التي يعاني منها العمال في ظل الرأسمالية:
- الاغتراب عن ناتج العمل: حيث لا يمتلك العامل ما ينتجه، بل تذهب ملكية المنتج النهائي إلى الرأسمالي، مما يجعل الإنتاج ذاته عملية مغتربة عن العامل. فالعامل يبذل جهده لكنه لا يملك ما ينتجه، بل يُفرض عليه واقع يصبح فيه المنتج قوة غريبة تسيطر عليه.
- الاغتراب عن عملية الإنتاج: حيث لا يملك العامل السيطرة على شروط العمل وطريقة الإنتاج، بل يجبَر على اتباع نمط إنتاجي محدد لا يخدم تطوره الذاتي، وإنما يخدم متطلبات السوق والرأسماليين. فالعمل يتحول إلى وسيلة للبقاء وليس إلى نشاط إبداعي حر.
- الاغتراب عن الذات: إذ يفقد العامل إحساسه بهويته الحقيقية، ويصبح العمل مصدرا للمعاناة بدلاً من أن يكون وسيلة لتحقيق الذات، حيث يشعر العامل بأنه مستلب ومستنزف ضمن عملية الإنتاج.
- الاغتراب عن الآخرين: إذ تؤدي البنية التنافسية للرأسمالية إلى تفكيك العلاقات الاجتماعية، مما يجعل العمال في حالة صراع دائم بدلاً من التضامن، إذ تتحول علاقاتهم إلى علاقات مبنية على المصلحة الاقتصادية بدلاً من القيم الإنسانية.
يرى ماركس أن السبب الجذري للاغتراب يكمن في الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والتي تجرد العمال من السيطرة على حياتهم، وتجعلهم مجرد أدوات في يد الطبقة الرأسمالية، التي تكرس هذا الاستغلال لتحقيق المزيد من الأرباح. وبالتالي، فإن تجاوز الاغتراب يتطلب إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وإقامة نظام اجتماعي يكون فيه الإنتاج لخدمة الجميع، وليس لخدمة فئة محدودة من الرأسماليين.
الاغتراب في القرن الحادي والعشرين
إذا تمت قراءة الأوضاع والتغيرات في النظام الرأسمالي في القرن الحادي والعشرين بطريقة دقيقة وموضوعية، وتم إجراء دراسة مقارنة بين هذا العصر والفترة التي كتب فيها ماركس تحفته "رأس المال"، فسيتم ملاحظة اختلاف واضح. فرغم أن الرأسمالية لم تتوقف عن كونها النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد، إلا أن التحولات الجوهرية والأساسية التي شهدها النظام لم تؤدِ إلى القضاء على جذوره
السبب الرئيسي الذي یكمن في الطابع الاستغلالي للرأسمالية، كما أشار إليه ماركس، هو الارتباط الوثيق لمفهوم الاغتراب بفائض القيمة. وفي القرن الحادي والعشرين، لا يزال هذا المفهوم قائماً ولكن بأساليب وأنماط مختلفة. فبالرغم من أن العمال والقوى العاملة قد يحصلون الآن على أجور أعلى مقارنة بالقرون السابقة، إلا أن هذه الزيادة تعتبر قطرة في محيط إذا ما قورنت بتضخم أرباح ورؤوس أموال الطبقات الرأسمالية، مما يساهم في استمرار وتعميق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية.
في الجزء الرابع من كتاب "العائلة المقدسة" (1845)، يشير ماركس إلى أن كلًا من الرأسماليين والبروليتاريا يتعاملون مع ظاهرة الاغتراب بطرق مختلفة. فبالنسبة للرأسماليين، الاغتراب عامل أساسي لتحقيق وجودهم وتعزيز مكانتهم، بينما يمثل الاغتراب للعمال مصدراً للضغط المعيشي وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
هذا التقابل يؤدي إلى تفاقم الظلم الاجتماعي، حيث يؤدي تراكم الأرباح لدى الرأسماليين إلى المزيد من الفقر والتهميش للطبقات العاملة. حتى الآن، فإن الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج، التي تترك العمال محرومين من نصيبهم في الثروة، تظل السبب الأساسي لاستمرار الاغتراب، إلى جانب تقسيم العمل الذي يؤدي إلى تجزئة عمليات الإنتاج، والسيطرة على القوى العاملة، وتحويل العمال إلى أدوات داخل الآلة الإنتاجية الرأسمالية.
في ظل هيمنة الرأسمالية الحديثة، يؤدي العدم إلى تعزيز البطالة وتزايد أعداد الفقراء الذين يفقدون السيطرة على حياتهم، مما يولد الشعور بالعزلة والتهميش الاجتماعي ويزيد من الأزمات النفسية والاجتماعية. هذا التآكل الاجتماعي يعدّ إحدى أبرز ملامح الاغتراب والعدمية في القرن الحادي والعشرين.
أما على الصعيد السياسي، فإن تركيز القوة الاقتصادية في أيدي الشركات العملاقة العابرة للقارات يعزز عدم ثقة الشعوب في الأنظمة السياسية، حيث يشعر الأفراد بأنهم مجرد أرقام في لعبة الاقتصاد العالمي، وأن القرارات السياسية لا تعكس مصالحهم الحقيقية، مما يدفعهم نحو الشعور بالعجز والإحباط.
وفي ما يتعلق بالثقافة، يؤدي الاغتراب إلى زيادة هيمنة الاستهلاك المادي، بحيث يُقاس الإنسان بناءً على ممتلكاته وليس على قيمته ككائن بشري. وهكذا، فإن التوسع في الرأسمالية النيوليبرالية يؤدي إلى تعميق أزمة الإنسان الحديث، مما يفتح المجال أمام الشعبوية لتقديم حلول سطحية ووعود زائفة لمحاولة التعامل مع هذا العدم المتجذر في النظام الرأسمالي.
الاغتراب هو سمة حتمية للرأسمالية العالمية، وفي دول مثل بلدنا، يتجلى هذا الاغتراب عبر الفوارق الطبقية الحادة والتناقضات الاجتماعية التي تعكس مستويات متفاوتة من التطور الرأسمالي والوعي الطبقي.
ورغم أن الماركسية تشير إلى أن الحل يكمن في الإطاحة بالنظام الرأسمالي واستبداله بنظام أكثر عدلاً، إلا أن تحقيق هذا البديل لا يزال بعيد المنال، مما يجعل النضال ضد الاغتراب مسؤولية قائمة تتطلب العمل على:
-تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية عبر الحد من الفجوة بين الطبقات، وتحقيق المساواة بين الجنسين في الأجور وسوق العمل.
-إعادة النظر في ثقافة العمل لضمان توازن صحي بين الحياة المهنية والشخصية.
-تعزيز الروابط الاجتماعية لمنع تفكك العلاقات الإنسانية بسبب التكنولوجيا والتغيرات الاقتصادية.
-الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التنوع والتعددية في مواجهة العولمة الرأسمالية.
-ضمان مسؤولية الدولة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
-رفع الوعي البيئي كجزء من مسؤولية عالمية للتقليل من آثار الرأسمالية المدمرة على البيئة.
-الاهتمام بالصحة النفسية ووضعها ضمن السياسات الوطنية والدولية لضمان مجتمع أكثر توازناً.
-توجيه الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية بدلاً من أن يصبح أداة لتعزيز استغلال رأس المال. إن استمرار الأزمات الرأسمالية يجعل العدم ظاهرة لا مفر منها، مما يؤدي إلى مزيد من القلق والاغتراب. ومع تصاعد النفوذ النيوليبرالي، يتم تقييد حياة الأفراد في دوامة الاستهلاك، مما يعمق الأزمات الروحية والنفسية للإنسان الحديث.
الاغتراب هو الوجه الحقيقي للرأسمالية، ومن دون تغييرات جذرية في بنية هذا النظام، سيظل الإنسان عالقاً في دوامة الاستغلال والتهميش.