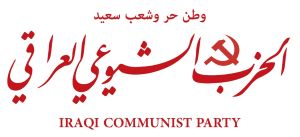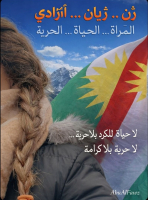ارتبطت الثقافة تاريخياً بموقع معرفي ينتج الأفكار والتصورات والتأويلات، ويطرح البدائل الممكنة للفهم. ولذلك، اعتُبر المثقف مرجعاً للتحليل والتفسير والتفكير. وإذا كان تاريخ الأفكار والفلسفات قد مكّن الثقافة من تحديدات فلسفية تستجيب لمتطلبات كل مرحلة، فإن المثقف تحول إلى مرجع للفهم وإنتاج المعنى. دعم مفهوم المرجع امتلاك المثقف أدوات ومناهج التحليل، وخلفيات فكرية وثقافية أهلته لكي يصوغ رؤية تضيء الفوضى في الفهم. اختلفت الثقافات باختلاف السياقات، وتعددت مرجعيات المثقف بتنوّع المدارس والتيارات، وشهد الحوار الثقافي بين المثقفين جدالات ونقاشات، تأخذ أحياناً طابع الاصطدام الشديد، وخصوصاً عندما تتناقض مرجعيات المثقفين. وسمح هذا الاصطدام بتطوير التأويل والفهم، غير أن الثابت ظل واحداً، هو الإيمان بالمثقف باعتباره مرجعاً للتحليل والفهم والتفسير والتأويل. ولذلك، عندما نقرأ تحليلات المفكرين والمثقفين وإن اختلفت في تصوراتها، نلاحظ خيطاً ناظماً لهذه الخطابات، ولا يقوم تحليل إلا على ثقافة أخرى، وأفكار مثقف آخر، وهو الأمر الذي طوّر الفكر الجدالي، وحوار الأفكار، وجعل مفهوم الآخر حاضراً في كل الخطابات. وبملاحظة سريعة، استطاعت الخطابات الثقافية نسف مفهوم الإقصاء بجعل التفكير الثقافي استمراراً وتطويراً لما سبق، ولما هو موجود، ولما سيأتي. هل ما زال الاعتقاد بمرجعية المثقف قائماً؟ وهل ما زال الخطاب الثقافي مقنعاً؟ هل يمكن الحديث اليوم عن خطابات ثقافية مؤثرة؟ وهل ما زال المثقف يشكل تحدياً للخطاب السياسي والذهني الاجتماعي؟
يقف وراء هذه الأسئلة وضعية المرجع اليوم مع زمن التكنولوجيا، وانتشار المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهيمنة مرجعيات جديدة، تأخذ سلطتها من السوشال ميديا، وتنتقل بسلطتها إلى الإعلام الرسمي، فتمتلك سلطة مضاعفة، تحولها إلى مرجع مدعم ومؤثر، مثل: الخبير والاستشاري والاستراتيجي والمؤطر والمؤثر، إضافة إلى انتقال كل مستخدم للمنصات التكنولوجية من فرد عادي إلى صاحب سلطة على متابعيه ومشاهدي محتواه. ولعلها وضعية تعيد النقاش إلى وضعية المثقف اليوم، ودور الثقافة في تدبير الفهم، وإنتاج التأويلات الممكنة. إن الانتقال التاريخي إلى العصر التكنولوجي هو انتقال بنيوي يمس كل مناحي الحياة، وينعكس على الإدراك والوعي، لكونه يغير المواقع، ويؤثر في المنظورات، وينتج تأويلات مختلفة عن المألوف. وبالتالي، فإن المجتمعات لم تعد أمام مرجع ثقافي موحد، كما لم يعد البحث محدداً في مفهوم الحقيقة، واتباع الطريق للوصول إليها، بقدر ما أصبحت المجتمعات البشرية أمام تحدي تعدد المرجعيات، وتنوّع سياقاتها، بل إن كل مستخدم للمنصات التكنولوجية يتحول بدعم من ارتفاع عدد المتابعين والمشاهدين والمتقاسمين للمحتوى، إلى مرجع مؤثر في المتابعين.
ونظراً إلى مفهوم السرعة التي تميز خدمات التكنولوجيا، وارتباط الاستخدام وصناعة المحتوى بالمال، فإن أفراد المجتمعات ينتقلون بسرعة من الواقع المادي إلى الواقع الافتراضي، والإقامة في المنصات بمحتويات استهلاكية مادياً ومعنوياً ونفسياً وقيمياً، وبلغة تنزاح عن المتعاقد عليه ضمن نسق مجتمعي، واعتماد الشعبوية لتحقيق أعلى المشاهدات والمتابعات مع كل الفئات، والنزوع نحو الافتراضي باعتباره أرض السخاء والعطاء، بعيداً من انتظار مشاريع التنمية في برامج الحكومات، وشعارات الانتخابات، وصراعات الأحزاب.كيف إذن يمكن تحليل الوضع، وبأي مرجعية، وما هي التيارات الفكرية الأكثر اقتراباً من تأويل الوضع؟ وهل نحتاج إلى مدارس جديدة، وأدوات مختلفة في التحليل، وأي خطاب ثقافي يستطيع أن يصوغ تأويلاً ممكناً للوضع؟
ولأن الافتراضي تحول إلى إقامة شبه دائمة لغالبية مستخدمي السوشال ميديا والمنصات الرقمية، ويزداد الولوج إلى هذه الإقامة بسرعة لافتة للنظر، نتيجة للإغراء المادي الصادم من جهة، ولكون الولوج لا يتطلب إمكانات مادية وتكوينية تقنية كبيرة، فإنّ الأمر ينزاح بالفهم إلى مناطق بعيدة، ويضعه أمام منطق الاحتمالات، ما دام الكل تحول إلى مرجع لحقيقة محتملة، ويمتلك خدمة الإغراء للمتابعة، ويتوفر على قدرة التأثير الصادم. أمام المثقف اليوم تحد مزدوج: من جهة أولى مواجهة موقعه المألوف، والبحث عن موقع جديد ضمن التركيبة الجديدة لمرجعيات إنتاج الفهم، ومن جهة ثانية العمل على تجديد أدوات التفكير ومناهج التحليل، واعتماد الرقميات في خطاب التحليل باعتبارها عاملاً محدداً للفهم، لكونها فاعلاً وظيفياً في الحياة والمجتمع والاقتصاد والسياسية، ما جعل من الصعب التفكير في أي ظاهرة أو وضعية كيفما كانت من دون استحضار العامل الرقمي. يدخل هذا التحدي المزدوج للمثقف في ما يسمى اليوم بــ«مراجعة المفاهيم»، الذي يحتم على المثقف مراجعة موقعه من أجل انتماء تاريخي في العصر التكنولوجي، وتأثير الموقع الجديد في المنظور والتصوّر والرؤية، ثم الانخراط في الثقافة الرقمية باعتبارها منظومة من الأفكار والتصورات والتأملات، وكذا الوسائط الإدراكية. إن العالم اليوم بقيادة التكنولوجيا، والتباس العلاقة بين الإنسان والتقنية، وتحكم الخوارزميات في المستخدم التكنولوجي، وتسرب ثقافة الرعب من تحديات الذكاء الاصطناعي للعقل البشري، وتهديد الروبوت للإنسان في فرص حياته وعمله وتنميته، وانتشار بؤر التوتر في مناطق عالمية، مع استمرار الحروب، وانتشار ظاهرة النزوح والهجرة التي لم تعد سرية، وتوسع قاعدة العنصرية، وتراجع قيم السلام والمحبة والتأخي بسبب الصراعات الدولية الجديدة، رغم الخدمات التكنولوجية التي تمكن إنسان القرن الحادي والعشرين من إمكانات وفرص للاكتشاف والمغامرة والوصول إلى مناطق جديدة واقعياً وافتراضياً... هو عالم يحتاج إلى ثقافة جديدة، وطرق تفكير مختلفة، وتأويلات تتماشى مع وضعية المجتمعات. إنه وضع مركب يتطلب تحليلاً وتأملاً مختلفاً، وثقافة جديدة تتبنى الوسائط الجديدة في إدراكها للتحول.
عندما يتخلى المثقف عن ثقافة تجديد ذاكرته المرجعية، ويظل ثابتاً في موقعه من دون التساؤل حول دوره الجديد، فإنه يسمح بهيمنة المراجع الجديدة القادمة من المنصات التكنولوجية، ويتحول -بدوره- إلى عنصر خلل تاريخي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* أكاديمية وناقدة مغربية
“الأخبار” اللبنانية – 7 أيلول 2024